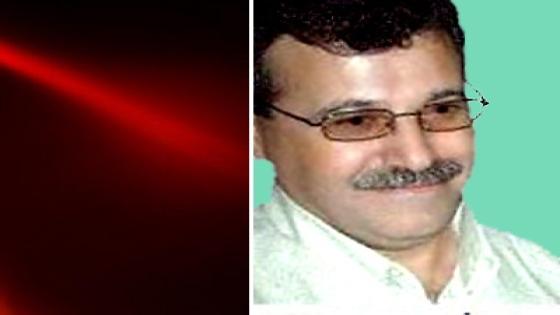لم يتوقع أحد أن يصل المشهد السوري إلى ما وصل إليه مثقلاً بهذا العنف والدمار، وأن يغدو السلاح صاحب الكلمة الفصل، ويعلو صوت المعركة على أي صوت، وتنحسر السياسة وشعارات الحرية والكرامة التي رفعتها المظاهرات الحاشدة أمام المطالبة بالسلاح، وأن تحتل أخبار الجيش الحر وسيطرته على بعض المدن والمناطق الحيز الأكبر من الاهتمام.
أسباب هذا التحول متعددة ومتضافرة، وتتحمل السلطة المسؤولية الأولى والرئيسة عنه، من خلال إصرارها على إنكار مطالب الناس وإظهارهم كأدوات تآمرية وطائفية يحل سحقهم، وتوظيف أفتك الأسلحة وأشنع الممارسات الاستفزازية لتشويه الثورة والطعن بشعاراتها، وإجبار الناس على تهميش الحقل السياسي والتخلي عن السلمية، كي تسوغ لنفسها خيار العنف وتشرعن القهر والقمع بذريعة مواجهة الإرهاب وعصاباته المسلحة، وبدعوى الحفاظ على الأمن وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
لقد تراجع النهج السلمي تحت وطأة الخسائر الفادحة التي تكبدها الناس لأكثر من عشرة شهور، من دون أن يقطفوا ثماراً مستحقة لقاء رهانهم على نهج لم يرتد عليهم بما كانوا يرجون، وخاصة في وقف العنف ووضع الأمور على سكة التغيير السياسي.
أولاً، رهان خاسر على دور الجيش في إنجاز التغيير أسوة بما حصل في تونس ومصر، حيث بادرت السلطة إلى زجّه في المواجهة وتوريط بعض كتائبه في قمع المحتجين، فتبدلت شعارات المتظاهرين التي حاولت استمالة الجيش إلى هتافات تدين دوره القمعي، ممهدة الطريق لنشوء الجيش الحر كإطار جديد يضم الضباط والجنود المنشقين أو الفارين الذين وقفوا مع الحراك الشعبي ورفضوا إطلاق الرصاص على أهلهم.
ثانياً، عدم حصول تحول لقطاعات مهمة من المجتمع لا تزال خائفة لأسباب عدة، ومحجمة عن الانخراط في عملية التغيير وتستسلم لتشويش ومبالغات في قراءة أحوال الثورة ومآلاتها، عززها تنامي مخاوف بعض الأقليات من فوز الإسلاميين وتحسبها من مظاهر التضييق والتنميط المرافقة لهذا النوع من الجماعات، التي تحاول عادة فرض أسلوب حياتها وثقافتها على المجتمع، وتهديد هوية هذه الأقليات وحقوقها وطرق عيشها.
ثالثاً، واقع المعارضة السورية التي لم تستطع طمأنة الرأي العام، ولا تزال ضعيفة التأثير في الحراك الشعبي ومقصرة في إبداع أشكال من النضال السلمي كفيلة بتبديل المشهد والتوازنات القائمة، وهنا لم يشف الغليل السلمي للثائرين النجاح الجزئي لخطة الإضراب العام الذي برمجته المعارضة أواخر العام المنصرم، وكان يفترض أن يتوج بعصيان مدني، أو إغلاق المحلات التجارية في مختلف المدن السورية وخاصة دمشق وحلب إثر مجزرة الحولة..
وهما حدثان لم يتكررا بسبب القمع والحصار الشديدين الذين مارستهما السلطة ضد التجار والصناعيين وأجبرت أكثرهم على الهرب خارج البلاد، مما يؤكد أن اللجوء إلى السلاح تزامن مع عجز الحراك السلمي وانعدام فرص استمراره وتوسعه جراء العنف المفرط المتجرد من أي وازع أخلاقي.
رابعاً، وهو العامل الأهم، فشل الرهان على النضال السلمي في استجرار دعم خارجي عربي أو أممي قادر على التدخل لوقف القمع المعمم، وفرض مسارات سياسية لمعالجة الأوضاع المتفاقمة.
ولا يغير هذه الحقيقة -بل يؤكدها- فشل المبادرة العربية وانسداد الأفق أمام المبعوثين الدوليين، كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار لحماية المدنيين بسب تكرار الفيتو الروسي والصيني، وإذا أضفنا النتائج الهزيلة التي توصلت إليها مؤتمرات أصدقاء الشعب السوري، نقف أمام أهم الأسباب التي أفقدت المحتجين صبرهم وهزّت ثقتهم بجدوى البحث عن داعم لهم.
ومع لا جدوى المناشدات بفرض حظر جوي أو منطقة آمنة، صار شعار “ما لنا غيرك يا الله” يتواتر ويتواتر معه الحرج الأخلاقي والصمت الحزين تجاه دعوات الرد على العنف بعنف مضاد.
فكرة تشكيل قوة عسكرية بدأت مع الانشقاقات الأولى في صفوف الجيش، وكانت الفاتحة إعلان لواء الضباط الأحرار، قبلها تنامت ظاهرة العسكرة كشكل من أشكال الدفاع الذاتي عن النفس وحماية المتظاهرين بما يتوفر من أسلحة بسيطة، واتسمت بمعظم السمات العفوية التي عرفها الحراك الشعبي.
العفوية في كتائب عسكرية لم تنبثق عن حركة سياسية، إذ ليس هناك رؤية مسبقة بأن المعركة ستخاض عسكرياً مع النظام، ولم يفكر طرف من المعارضة ببناء ما يمكن اعتباره الجناح أو الذراع العسكري كما هي العادة في الحركات التي تجمع بين النضالين السياسي والعسكري.
والعفوية في غياب رؤية تنظيمية، فقد شهد تطور الجماعات المسلحة مساراً تجريبياً، حاكى تجربة التنسيقيات، عبر تشكيل وحدات محلية منفصلة عن بعضها أخذت أسماء كتائب أو ألوية، واستقوت -مثل التنسيقيات- بمظلة عامة كالمجالس العسكرية في المحافظات والمدن ثم بإطار عام موحد سمي الجيش السوري الحر.
والعفوية في أن ظاهرة الجيش الحر ليست جامعة تضم كل المسلحين، من منشقين عسكريين ومدنيين متطوعين، ولا تحكمها قواعد واحدة ومرجعية واحدة وخطة عمل مشتركة، بل هي أقرب إلى كتائب ومليشيات شبه منظمة تقود المقاومة العسكرية على نمط حرب الشوارع، مما يفسر تواجد عدة فصائل متمايزة تحمل اسم الجيش الحر في منطقة واحدة، وغالباً دون تنسيق جدي بينها أو هو في أضعف حالاته.
وتأسيساً على ما سبق، يمكن تقسيم من ينضوون تحت اسم الجيش الحر أو يجاهرون بحمل اسمه، إلى أربع مجموعات تختلف باختلاف المنبت والرؤية السياسية والكفاءة العسكرية والوازع الأخلاقي.
أولها، وهي الأهم وتضم الكثير من الضباط والجنود الذين انشقوا عن جيش النظام لرفضهم إطلاق الرصاص على أهلهم، ولاعتراضهم على زج الجيش الوطني في حرب ضد المجتمع، وهم الأقرب إلى احترام قواعد التنظيم العسكري ربطاً بخصوصية عملهم، ولنقل الأكثر أخلاقية وحرصاً على استخدام السلاح بشكل آمن.
وهؤلاء إذ يلتفون حول هدف واحد هو إسقاط النظام وإنقاذ شعبهم من براثن الفتك، ثمة تفاوت كبير في خياراتهم السياسية ونظرتهم للمستقبل، لكن ما يعزز حضور هذه المجموعة ودورها، تزايد الانشقاقات بين الضباط الأمراء في الجيش والشرطة، مما يمنحها كوادر مجربة تمتلك رؤية أوضح للأمور ومرونة في التعاطي مع القوى السياسية المعارضة والتنسيق معها.
واللافت أنه حيث تكون الكتلة الأعظم من خلفيات عسكرية ينجح الجيش الحر في الحفاظ على الأمن وتخفيف التجاوزات، وهو ما شهدناه في إدلب ودرعا وأرياف حلب وحمص وحماة، وهي المناطق التي شكلت تاريخياً خزاناً لمتطوعي الجيش والشرطة، بينما يختلف الأمر في مدن أخرى، كدمشق وريفها، بسبب الإحجام التقليدي لسكانها عن الالتحاق بالقوات العسكرية أو الأمنية، مما سمح بطغيان العنصر المدني على تشكيلات الجيش الحر هناك وسمح لأصحاب السوابق بتبوؤ مواقع المسؤولية.
ثاني المجموعات تشكل القسم الأكبر من مكونات الجيش الحر، وتضم المتطوعين من المدنيين الذين أكرهوا على حمل السلاح دفاعاً عن أهلهم وممتلكاتهم أو هرباً من اعتقال وتعذيب، وعناصرها هم من كانوا يشكلون الكتلة الرئيسة للتظاهرات السلمية.
لكن تحت وطأة فتك النظام وهمجيته، بدأ الحراك الشعبي يشهد تحولات لتغليب الرد على العنف بعنف مضاد، تعزز بغياب أهم الكوادر القديمة التي عرفت بنزعتها السلمية جراء القتل أو الاعتقال أو التهجير، وحل مكانها عناصر أقل عمراً وتجربة، وأكثر حماسة للتفاعل مع النتائج التي يحققها اللجوء إلى السلاح أو التهديد باستخدامه.
وزاد الجرعة الانفعالية تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي الناجم عن الحصار وتطبيق عقوبات انتقائية ظالمة بحرمان مناطق الاحتجاج من أهم الحاجات الإنسانية.
ولعل الإيجابي في هذه المجموعة، هو انضمام العديد من أصحاب الخبرات العلمية إلى صفوفها من أطباء، ومهندسين، ومدرسين، صارت الثورة بالنسبة لهم خيار وجود أو لا وجود، في ظل ما يكابدونه ويعانون منه.
ثالثها، هي عناصر من السلفيين والجهاديين الذين وجدوا في مناخات الثورة وانكشاف الصراع الطائفي فرصة لزج أنفسهم في المعركة. وهؤلاء، مع الاعتراف بشدة بأسهم وإخلاصهم لمبادئهم واستعدادهم العالي للتضحية والشهادة، هم الأبعد سياسياً عن شعارات الحرية والديمقراطية.
وهم كذلك الأكثر استسهالاً للتجاوزات والأعمال الانتقامية ضد النظام، وما يزيد الأمر تعقيداً زيادة أعداد المقاتلين الوافدين من الخارج لنصرة الإسلام في بلاد الشام، وتدخل المال السياسي في تمويل بعضها وخاصة الأكثر تطرفاً.
رابع المجموعات يمكن اعتبارها عصابات جنائية تشكلت من السجناء وأصحاب السوابق ممن أفرج النظام عنهم مع بداية الثورة، فوجدوا في الظروف الأمنية القائمة فرصة ثمينة لممارسة نشاطاتهم من تهريب وسرقة وخطف وابتزاز، وانضم إليهم بعض ضعاف النفوس والباحثين عن إثراء سريع، وهؤلاء لا علاقة لهم بالثورة وأهدافها، بل باتوا يشكلون عبئاً ثقيلاً عليها، خاصة عندما يطلق بعضهم لحاه ويتمكن من قيادة جماعة من المتطوعين تحت عنوان الدفاع عن الإسلام مسوغاً لنفسه ما يحلوا له من تجاوزات.
صحيح أن النظام جاهد لتحويل الاحتجاجات من مسارها السلمي والسياسي إلى مسار عنفي وأهلي، وأمل في إخضاع المجتمع لقواعد لعبة يتقنها جيداً وتمكنه من إطلاق يده كي تتوغل أكثر في القهر والتنكيل، مدعوماً بما يملكه من خبرات أمنية، ومن توازن قوى يميل على نحو كاسح لمصلحته.
لكن يبدو أن السحر انقلب على الساحر وبات وجود الجيش الحر أحد أهم الهواجس المرعبة، يستنزف قوى النظام ويفقدها السيطرة على العديد من المناطق، مما اضطرها لاستخدام العقاب الجماعي والتنكيل العشوائي بالمدنيين، وتدمير مساكنهم ونهبها سعياً لتشويه العلاقة بين عناصر الجيش الحر، والبيئة الاجتماعية الحاضنة لهم.
ألا يخلق الثمن الباهظ الذي يتكبده الناس حالة من التململ والتشكيك في جدوى ما يحصل؟! ألم تصدر عبارات التذمر بسبب تعرض الأماكن التي يتواجد فيها الجيش الحر لقصف عنيف ومركز، أو بسبب ضعف قدراته على تنظيم الحياة في المناطق التي سيطر عليها ربطاً بحرمانها المقصود من أبسط وسائل الحياة والصحة والمعيشة؟!
تكثر الدعوات اليوم لبناء الثقة مع الناس، لإدارة عادلة للمناطق التي صارت تحت سيطرة الجيش الحر، ومحاربة التجاوزات وعزل المقاتلين الذين لا علاقة لهم بالثورة، ووضع ميثاق الشرف الصادر عن المجلس العسكري، ثم إنذاره للغرباء بمغادرة البلاد، موضع التنفيذ.
وأيضاً لتوحيد كل الجماعات المسلحة تحت قيادة واحدة، والتنسيق مع قيادات المعارضة السياسية لحصر قنوات الدعم ولضبط استخدام السلاح وفق رؤية واضحة تحمي الثورة وأهدافها، وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
والحال، إذ يدرك الجميع أن مخاض الثورة طويل، وأن اللجوء إلى السلاح يعني تنحية الحقل السياسي، وبدء إخلاء ميدان القوة الشعبية لمصلحة القوة العارية، تنهض الأسئلة.
هل لا يزال بالإمكان إعادة الروح السلمية للثورة، أم أن التنكيل الشديد أطاح مرة واحدة بها وبدور الاحتجاجات الشعبية؟!
وهل هو خيار حتمي أن يصبح مصير الثورة في يد حملة السلاح وما يخلفه ذلك من مخاطر على فرص نجاحها، ومستقبل شعاراتها، وطبيعة المرحلة الانتقالية التي يتطلع الجميع إلى تجاوزها بأقل الآلام؟!
وهل لا يزال بالإمكان الرهان، ربما على دور خارجي حاسم يوقف العنف ويفتح الباب للتغيير السياسي، وربما، على الارتقاء بمسؤولية المعارضة السياسية في تمكين الاحتجاجات السلمية بالتنسيق مع الحضور العسكري، وفي بلورة خطاب واضح حول الأفق الديمقراطي للتغيير يسرّع انتشار الثورة بين مختلف فئات المجتمع، مما يعزز ثقة الناس بوحدتهم وبجدوى نضالاتهم وبقدرتهم على نقلها إلى أطوار مدنية جديدة تحقق لهم أهدافهم وتجنبهم مثالب تغليب لغة العنف والقوة؟