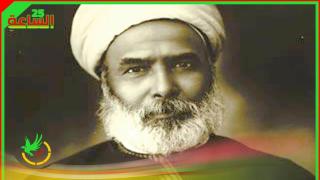ثمة صعوبة كبيرة في تحديد وفرز أنماط النسق السلطوي في العالم العربي، ذلك أن كل دولة تحتفظ بخصوصيات تميز نظامها السياسي. الدراسات المقارنة لأنظمة السلطوية في العالم العربي تفرق
ثمة صعوبة كبيرة في تحديد وفرز أنماط النسق السلطوي في العالم العربي، ذلك أن كل دولة تحتفظ بخصوصيات تميز نظامها السياسي. الدراسات المقارنة لأنظمة السلطوية في العالم العربي تفرق بين الأنماط المغلقة، وبين الأنظمة شبه السلطوية. ضابط التمييز أن الدولة في الأنماط السلطوية المغلقة تحتكر المجال العام بشكل مطلق، وتترك الأنماط شبه السلطوية بعض الهوامش للنخب السياسية ضمن مجال موضوع تحت المراقبة مع قدر من الانفتاح المتردد في مجال الحريات. ثمة معايير أخرى تعتمدها بعض التقارير الدولية للتمييز بين أنماط النسق السلطوي لوصف هذه الدولة أو تلك بالفاشلة أو الهشة، بعضها يعتمد المعايير السياسية والحقوقية وبعضها الآخر يعتمد مؤشرات التنمية الاجتماعية.لكن، مخرجات هذه التصنيفات لا تعطي صورة واضحة عن طبيعة النسق السلطوي في كل بلد، إذ في الوقت الذي تبعد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بعض الدول عن دائرة الهشاشة والفشل، تأتي المؤشرات السياسية والحقوقية وتجعلها في صدارة الدول الفاشلة.ملاحظات علم الاجتماع السياسي بصدد الدول التي اندلعت فيها الثورات كانت أيضا متباينة، ففي الوقت الذي عزت بعض الدراسات أسباب قيام الثورة في تونس إلى عدم توسيع النسق السلطوي لدائرة المنتفعين من الثروة، وانحصار ذلك في أسرة جمعت بين النفوذ والثروة، لاحظت دراسات أخرى فروقا جوهرية تميز النسق السلطوي في مصر عن تونس، إذ رغم توسع دائرة المنتفعين من الثروة ممن يدورون في محيط السلطة في مصر، فإن الأزمة بدت أكثر في بنية السلطة أكثر من شكل توزيعها وإدارتها للثروة.في تونس، تجلت أزمة النسق السلطوي في مظهرين: الأول وهو استفراد نخبة ضيقة للسلطة والثروة وإنتاج منظومات القيم الموازية، والثاني، وهو احتكار المجال العام بشكل مطلق، إذ كانت الدولة تبحث عن متعاونين، أو بالأحرى متواطئين، ينفذون ما تريد بمقابل في غياب أي نخب تقوم بالوساطة السياسية والخدمية. فالدولة تدير الشأن العام، والأحزاب ـ إن كانت ثمة أحزاب ـ لم تكن لها الحق حتى في الوصول إلى مربعات تدبير الشأن المحلي في الجماعات أو المحليات.أما في مصر، فالوضع كان مختلفا، فالمجال العام كانت تشتبك فيه إرادات كثيرة، وبه هوامش مهمة للفاعلين السياسيين والمدنيين، وحتى الإعلام والقضاء، ذلك المجالان اللذان أصبحا جزءا لا يتجزأ من أسلحة النسق السلطوي يمارس بها السياسة خارج طبيعتها، كان بهما قدر مهم من الانفتاح. لكن المشكلة كانت في جهة أخرى، فالنسق السلطوي كان ينتج آلية الحصار لعزل القوى الديمقراطية، فتظهر في صورة غير المعني تماما بالوساطة لتدبير أزمة النسق السلطوي في حالة الاشتباك مع ضغط الطلب الاجتماعي. في الحالتين معا، أي حالة تونس ومصر، وبسبب ضغط الطلب الاجتماعي، وبغض النظر عن طبيعة النسق السلطوي، وهل هو مغلق أو شبه سلطوي يتمتع بقدر من الانفتاح، فقد كانت النتيجة واحدة، بحكم أن النخب السياسية والمدنية في حالة تونس ومصر كانت عاجزة عن القيام بأدوار الوساطة، بل وجدت نفسها هي الأخرى معنية بالانخراط في الحراك أو على الأقل التزام الحياد أو استثماره وممارسة التفاوض مع النسق السلطوي بناء على دينامياته. في دول الخليج يبدو الأمرمختلفا تماما، فرغم عدم وجود أنظمة الوساطة أو محدوديتها، فإن خفة الطلب الاجتماعي بسبب أوضاع تنموية مريحة أو قرارات رفعت الكلفة ولو تكتيكيا، أبعدت الحراك نسبيا عن المنطقة، إلا في الدول التي اختلط فيها الحراك بحسابات طائفية.أما في المغرب، فإن انتباه الدولة مبكرا لضرورة توسيع دائرة المنتفعين وتحييد شرائح مهمة من الطبقة الوسطى بمنحهم امتيازات وظيفية ومهنية، خفف نسبيا من ضغط الطلب الاجتماعي على اعتبار أن الطبقة الوسطى في الغالب هي التي تقود أو تؤطر الحركات الاحتجاجية التقليدية أو الفئوية. لكن، استمرار هذه النمط لم يعف النسق السلطوي من أن يواجه الأزمة مع اشتداد ضغط الطلب الاجتماعي، وذلك لما حصلت تحولات في المشهد السياسي بعد انتخابات 2007، وبالتحديد لما قررت الدولة أن تنشئ حزبها الأغلبي، إذ حصل للأحزاب السياسية في المغرب ما حصل في مصر، وصارت لا تملك أي قدرة على لعب الوساطة مما جعل الحراك في 20 شباط/فبراير يتجه لتجاوزها ومخاطبة الدولة بشكل مباشر.خلاصة التحليل، أن ما عصف باستقرار النسق السلطوي في العالم العربي هو انهيار أنظمة الوساطة، وأن ما يشكل أزمته الجوهرية اليوم هو صيغة إشراك هذه النخب أو كيفية إدارتها لنظام الوساطة ونوع الصلاحيات والسلط التي تسند إليها.في المغرب، الذي يعتبر نسبيا نموذجا متقدما «ديمقراطيا» بالمقارنة مع عدد من الدول العربية، ثمة ازدواجية مقلقة في إدارة شكل الوساطة، فهناك من جهة الولاة والعمال أو ممثلو السلطات العمومية، وهناك من جهة أخرى المنتخبون ممثلو النخب السياسية الذين فازوا في العملية الانتخابية.تتمثل الأزمة في توسع صلاحيات ممثلو السلطة العمومية من غير خضوع للمحاسبة، وضيق صلاحيات النخب السياسية مع خضوعهم للمساءلة والمحاسبة.وجه أزمة النسق السلطوي في المغرب أن ممثلي السلطة فاعل سياسي غير محايد، وأن أي نجاح لفعل النخب يحتاج تعاونا مع ممثلي السلطة، هذا في الوقت الذي تقدر فيه السلطة لاعتبارات سياسية أو انتخابية تكتيكية أو استراتيجية التعاون مع هذه النخب وعدم التعاون مع تلك أو أحيانا محاصرتها وعزلها.والصورة «الماكرو» تظهر في استثمار الدولة للمساحات الرمادية في الدستور لإنتاج ديناميات سياسية قد تبلغ بها درجة تحقيق نتائج معكوسة للإرادة المعبر عنها انتخابيا باستغلال قوانين انتخابية تصنع بشكل مضبوط لمنع حصول أي نخبة على الأغلبية مما يجعلها مضطرة للتحالف مع نخب أخرى تكون بالضرورة صنيعة الدولة.في الدول الديمقراطية، ثمة صيغة واحدة ينضبط لها النسق السياسي، النخب التي تفوز في العملية الانتخابية هي التي تدبر الشأن العام وهي التي تحاسب، وفي حال حدوث أزمة تصير العملية الانتخابية الأداة الفعالة لتسوية أعطاب النسق السياسي، أما في العالم العربي، فالنخب السياسية تستدعى لتؤثث المشهد السياسي، ويمارس غيرها السلطة، ويكون مطلوبا منها أن تتحمل غضب الشعب، وفي الوقت ذاته أن تكون المنديل الذي تمسح فيه الأحذية، فينتعش النسق السلطوي بعملية تغيير النخب والتحكم في صناعة بعضها ليبدو المشهد جديدا وتستمر في ممارسة أسلوبها القديم في إدارة السلطة.التحولات التي تجري في العام العربي تؤشر على أن هذه اللعبة انتهت بشكل كامل، فالشعوب أصبحت تدرك الجهة التي تملك السلطة وتعي أن النخب بعيدة عن مراكز صناعة القرار، ولذلك بدأت تتجه بشكل مباشر لمخاطبة من يملك هذه السلطة.معضلة النسق السلطوي في العالم العربي أنه بإضعافه للنخب السياسية، وإصراره على أن يمارس السياسة بذات الأسلوب القديم الذي يضيق دور النخب ويحملها أعطاب أدائه وسياساته، سيدفع بشكل كلي إلى انهيار أنظمة الوساطة، وسينتج عن ذلك عودة الحراك من جديد وربما في ثوب أكثر راديكالية.
القدس العربي
<
p style=”text-align: right;”>هذا المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع