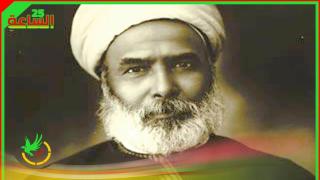ثمة شعور متزايد بأن الأوضاع في سورية تتجه نحو الاستقرار على ميزان القوى الراهن، وأن نظام الحكم يعمل على التعايش مع هذه الاوضاع.
وليس النظام وحسب، بل حتى القوى الإقليمية والغربية، المتحالفة مع النظام أو التي تقف منه موقف الخصومة، باتت تتعامل مع الملف السوري ليس كأزمة ملحة ولكن باعتباره حالة مزمنة.
في أوساط المعارضة السورية، بدأ ما يمكن وصفه باللوم المتبادل على ضعف الأداء وعدم إحسان التصرف، والهروب من جديد إلى أسطورة وحدة المعارضة، التي أصبحت مشجباً لعجز الجميع عن الفعل، سوريين وغير سوريين.
تكمل الثورة في سورية هذا الأسبوع شهرها الرابع عشر، مما يجعلها أطول الثورات العربية عمراً، وربما أكثرها دموية. وليس هناك ثورة شعبية في القرن الماضي، بما في ذلك الثورة الروسية والإيرانية، يمكن مقارنتها بالثورة السورية.
الأسباب الرئيسية خلف المدى الزمني المتطاول للثورة في سورية ليس من الصعب حصرها وتعدادها:
يسيطر على الحكم في سورية نظام أمني من صنف فريد، لم تعرفه لا روسيا القيصرية أو إيران الشاه، ولا حتى مصر وتونس وليبيا واليمن. وتنبع قوة ووحشية النظام الأمني السوري ليس من تعداد الأجهزة الأمنية فوق المعتاد وحسب، ولكن أيضاً من البنية الطئفية لهذه الأجهزة، التي تجعلها مجتمعاً يتصرف وكأنه ينتمي إلى شعب مختلف عن الشعب السوري.
والمدهش أنه حتى أثناء ما سمي بربيع دمشق، خلال الشهور الأولى التالية لتولي الرئيس الأسد الابن الحكم، عندما جرت المحاولة الأولى لصناعة وجه إصلاحي للنظام، لم تمس الأجهزة الأمنية على أي نحو أو آخر، لا قلص عددها ولا حددت صلاحيتها، ولا أعيد النظر في اشتغال الأجهزة العسكرية البحتة منها في الشأن السوري العام. وهذه الأخيرة هي خاصية سورية قلما وجد لها نظير.
الأكثر مدعاة للدهشة، أن النظام لم يتعرض لوضع ودور ونشاطات هذه الأجهزة طوال شهور الثورة الماضية، بالرغم من محاولته، للمرة الثانية، إقناع السوريين والعالم بعزمه على الإصلاح. وقد أوغلت أجهزة النظام الأمنية في دم السوريين وأعراضهم وممتلكاتهم وحياتهم طوال عقود، بحيث سيطر على كوادرها شعور لا مهرب منه بأن مصيرها مرتبط بمصير النظام، وأن سقوط النظام سيودي بها إلى الجحيم.
وليس ثمة شك في أن أجهزة النظام الأمنية خاضت، وتخوض، منذ اندلاع الثورة معركة لا مثيل لها ضد الشعب السوري، وضعت منظمات العمل المدني السورية في موقف العاجز عن متابعة مصير عشرات الآلاف من السوريين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب أو القتل والاغتيال.
وأقام النظام مؤسسة عسكرية فريدة في بنيتها وعقيدتها، يصعب حتى وصفها بالمؤسسة العسكرية. وكما أن هناك عدداً فادحاً من الأجهزة الأمنية التي تتنافس على الولاء للنظام والتمادي في انتهاك حياة السوريين، ليس هناك من قيادة عسكرية مركزية.
تنتمي القيادات الرئيسية للجيش السوري إلى لون طائفي واحد، وتتوزع مراكز القرار والنفوذ والسيطرة على العديد من القيادات العسكرية، بمن في ذلك أقارب الرئيس من الدرجة الأولى والثانية، التي ترتبط مباشرة برأس النظام. ما لا يذكر دائماً، حرصاً على الحساسيات الطائفية، أن كل المنشقين من الجيش هم من الضباط والجنود السنة.
ولكن الملاحظ، إضافة إلى ذلك، أن أعلى الضباط المنشقين كان من رتبة عميد؛ لأن عدد الضباط السنة الذين يمكن أن يصل إلى رتبة لواء ويحتفظ بموقعه القيادي في الجيش لا يكاد يذكر.
كل الجيوش الحديثة بنيت على الطاعة والانضباط والاستجابة لأوامر قيادتها. ولكن بنية الجيش السوري تجعله أكثر استجابة لأوامر قيادته، حتى عندما تتعلق هذه الأوامر بإطلاق النار على جموع المحتجين المسالمين من أبناء الشعب. ومن العبث انتظار انقلاب عسكري ما؛ ففي جيش كبير، يفتقد للقيادة المركزية، يصبح توافق الضباط الكبار على تغيير النظام مستحيلاً.
وفرت البنية الطائفية المضمرة للنظام، والمضمرة دائماً، وما قدمته الثورات العربية من فرصة لصعود القوى الإسلامية السياسية، في دول مثل تونس ومصر وليبيا واليمن، مناخاً مواتياً لسياسة الابتزاز الطائفي التي يوظفها النظام.
وعملت السياسة الطائفية في السابق على إحكام سيطرة النظام على أبناء الطائفة العلوية واستخدامهم أداة لخدمة بقائه واستمراره؛ ويعمل النظام اليوم على إثارة خوف أبناء الطائفة، وأبناء الأقليات الأخرى، من الصعود السني الموهوم، الذي سيهدد وجود الطوائف السورية غير السنية وامتيازات بعضها.
في مثل هذا المناخ، وبالرغم من محاولات قوى المعارضة الجاهدة لطمأنة كافة فئات الشعب السوري، فإن كتلة أقلوية من الشعب لم تزل تنظر إلى الثورة بقلق كبير، وتساهم في الحفاظ على الأمر الواقع، ليس تأييداً للنظام وإيماناً بسياساته وتوجهاته، بل خشية من المستقبل التي تعد به الثورة.
ولكن هناك شرائح اجتماعية أخرى تقف إلى جانب النظام وتحرص على استمراره، بفعل ارتباطاتها بشبكة علاقات القوة والثروة التي يستند إليها، أو احتلالها مواقع ومراتب مختلفة في هيكل نظام الحكم ومؤسسات الدولة التي يسيطر عليها، أو حتى الخوف من أداة البطش التي اعتاد النظام توظيفها للإضرار بمن يخرجون عليه.
إضافة إلى ذلك كله، أسست مقدرات سورية الجغرافية السياسية، وطبيعة النظام وسياساته الإقليمية الناجعة خلال العقود القليلة الماضية، لعدد من التحالفات الإقليمية الفعالة، التي وفرت له الدعم والحماية خلال العقد الماضي. خسر النظام في شهور الثورة الماضية تحالفه مع تركيا، بعد أن كان خسر تحالفه مع السعودية، ولكنه لم يزل يتمتع بدعم إيراني مطلق، دعم سياسي واقتصادي وبكل الوسائل الأخرى.
وبالرغم من صعوبة تقدير حجم وطبيعة الدعم العراقي لسورية، فإن عدداً من المؤشرات يدل على أن العراق عمل، ويعمل، من أجل تعزيز مقدرات النظام السوري، سواء استجابة من الحكم العراقي لضغوط إيرانية، أو بفعل المخاوف الطائفية التي تتخلل الفضاء السياسي المشرقي منذ احتلال العراق قبل زهاء العقد. ويضاف إلى الدعم الإقليمي للنظام، الذي تؤمنه العلاقات الوثيقة عميقة الجذور مع إيران، دعم دولي لا يقل أهمية، تؤمنه روسيا.
اندلعت الثورات العربية، والثورة السورية على وجه الخصوص، في لحظة تصاعد المساعي الروسية الحثيثة لتوكيد الموقع والدور، وشعور روسيا المتزايد بفقدان معظم أوراق الضغط التي تؤهل دولة نووية كبرى للعب دور فعال على الساحة الدولية. وليس ثمة شك في أن موسكو نظرت بعين الريبة لكل الثورات العربية، بما في ذلك الثورة المصرية، التي أطاحت بنظام حكم موال للولايات المتحدة.
باندلاع الثورة السورية، وجدت القيادة الروسية في سورية فرصة لتذكير جميع الأطراف المعنية بأن لروسيا دوراً رئيساً على الساحة الدولية، وأن مصالح روسيا الإستراتيجية في أوروبا والبلقان والقوقاز لا يمكن أن يطاح بها بدون عواقب.
في جوهره، لا يختلف النظام السوري عن أنظمة الاستبداد العربية الجمهورية، التي تطورت أدواتها واكتسبت سماتها الرئيسية في حقبة ما بعد يونيو 1967. ولكن جملة عوامل وقوى وظروف داخلية وخارجية خاصة هي التي ساعدت النظام السوري على الصمود في مواجهة الثورة الشعبية لفترة أطول من تلك التي استطاعها نظراؤه في تونس ومصر واليمن. هذا لا يعني بالضرورة أن النظام السوري قد نجا. ومن المبكر، المبكر جداً، لأنصاره وحلفائه الاحتفال بنجاته.
في مواجهة العوامل التي ساهمت في إطالة عمر النظام، ووفرت له حرية ممارسة القمع الوحشي للشعب السوري، هناك عوامل أخرى تشير إلى أن مصير هذا النظام لن يختلف في النهاية عن مصير أنظمة الاستبداد العربية الأخرى.
أول هذه العوامل أن النظام السوري، وفي ظل كل الظروف المواتية لاستمراره، داخلياً خارجياً، عاجز عن قهر إرادة الثورة والتغيير لدى جموع الشعب السوري.
خلال أشهر القمع الوحشي البالغ منذ أغسطس الماضي وحتى قدوم بعثة المراقبين الدوليين، اتسع نطاق حركة الاحتجاج الشعبية لتصل عدة أحياء من العاصمة دمشق، ومدينتي حلب والرقة، التي قيل في السابق أنها لم تلتحق بالثورة.
يخرج السوريون كل أيام الأسبوع، وفي أيام الجمعة على وجه الخصوص، في مئات التظاهرات الشعبية، التي تضم مئات الألوف من أبناء الشعب، توحدهم رغبة جارفة، وعزم لا يلين على بناء سورية حرة.
ربما لم يعرف السوريون هذا النظام كما يجب، ولكنهم يعرفون على الأقل أن تراجعهم عن مطلب إسقاط النظام والتغيير السياسي في بلادهم يعني أن النظام سيعود إليهم بنزعة انتقامية كبرى، وأن فرصة أخرى للثورة والتغيير قد لا تتاح لهم بعد عدة عقود أخرى. وبالرغم من أن الجيوش الحديثة لا تنشق عادة على نفسها، وحتى الثورات التي عرفت بأمدها الطويل، مثل الثورة الإيرانية في 1979، لم تشهد انشقاقاً عسكرياً ملموساً، فإن آلاف الجنود والضباط السوريين اختاروا خلال الشهور القليلة الماضية الانحياز لشعبهم.
وفي مقابل الدعم الإيراني الكبير للنظام، تجد الثورة السورية تعاطفاً واسع النطاق من الشعوب العربية، ودعماً متزايداً من عدد من الدول العربية، وتوكيداً تركياً قاطعاً على ضرورة الاستجابة لإرادة الشعب السوري، وإدراكاً دولياً لوحشية النظام وخروجه على الأعراف الدولية.
في النهاية، ستصل آلة النظام العسكرية والأمنية إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه، وتصل قدرة حلفاء النظام على تحمل أعبائه إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه. وعندها سنرى من جديد كيف تتشابه نهايات المستبدين.
هذا نظام فقد شرعيته، فقدها كلية، بما في ذلك تلك المستمدة من وقوفه إلى جانب قوى المقاومة في لبنان وفلسطين. وكلما طال أمد المواجهة بين النظام وشعبه، كلما تزايدت أعداد ضحايا قمع النظام ووحشيته، كلما أصبح من المستحيل استمرار النظام في حكم سورية، مهما بلغ الدعم الإقليمي والدولي الذي يتلقاه.