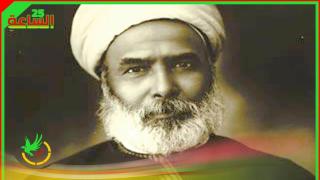لو أردنا تعداد منجزات الحل الأمني، الذي خص النظام السوري به شعبه ووطنه، لوجدناها متجسدة بوضوح ما بعده وضوح في المآثر التالية:
وضع السلطة في مواجهة عسكرية مع مجتمع يفترض أنها حاميته السياسية والوطنية، حيث يلزمها الدستور بالحفاظ على حياة وممتلكات ومصالح بناته وأبنائه، والحرص على تلبية تطلعاته وتنمية قدرته على تحقيق ما يريد، ما دامت مصالحه متداخلة مع مصالح الدولة العليا، التي تكرس حرية المواطن في المجالين الخاص والعام. هذه المواجهة العسكرية، التي قيل إنها تستهدف عصابات مسلحة، تتحول اليوم إلى اقتتال ينقلب أكثر فأكثر إلى حرب واسعة ليس لأحد على الإطلاق مصلحة فيها، لكونها تقوض دولة ومجتمع سوريا، وتدمرهما بالجملة والمفرق، وتنشر الجيش والأمن في كل شبر من الوطن وتتسبب في قتل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، وحتى الدواب والمواشي. كم سيلزم من وقت، في حال سلمنا بانتصار النظام على الشعب، قبل أن تعود سوريا إلى وضع طبيعي وتخرج من أجواء الثأر والانتقام والقتل المتبادل، إن كانت ستخرج منها في أي يوم؟ أتمنى أن يفكر أهل النظام في هذه النقطة، وأن يروا بعين المستقبل مصير أطفالهم وأحفادهم، وبيوتهم وممتلكاتهم، ويتأملوا قليلا وضعهم إن هم أمضوا بقية حياتهم وسط شعب معاد لا هم له غير الانتقام منهم، في زمن تنتشر فيه المفخخات والأحزمة الناسفة، ويستطيع أي فرد مهما كان بسيطا ودرويشا أن يستخدم تقنيات القتل ووسائله الحديثة! مع ملاحظة أنه يمكن للعالم أن يتدخل في أي وقت ويبدأ عمليات تسليح وتدخل متصاعدة ستكون نتيجتها قتل مزيد من السوريين والقضاء في نهاية الأمر على البلاد والعباد.
فتح أبواب سوريا أمام جميع ضروب التدخل الخارجي، المؤيد والمعادي، وخروج أقدار الشعب والدولة من يد أبنائهما، وإلا ما معنى أن يقبل النظام مراقبين عربا وأجانب ينتشرون في مدنه وقراه للإشراف على وقف إطلاق النار بينه وبين شعبه، وهو الذي اعتبر نفسه طيلة نيف وأربعين عاما رقم المعادلة الشرق أوسطية الصعب، والجهة التي تتدخل متى شاءت وكيفما شاءت في شؤون غيرها وتكلف نفسها بمهمة الإشراف عليه! ألا يسأل أهل النظام أنفسهم لماذا انقلب القسم الأكبر من دول وشعوب العالم عليهم؟ ولماذا فقدوا أغلبية أصدقائهم الساحقة، وهم الذين كانوا نقطة دولية وإقليمية ومحلية محورية، تلتقي فيها السياسات والمصالح وتتقاطع الخيارات والمواقف؟ ولماذا لم يبق لهم أي حليف حقيقي غير إيران؟ ولماذا تعلن روسيا جهارا نهارا أنها ليست صديقة نظامهم ولا تدافع عنه إلا لكي ترفع ثمن موافقتها على بديله؟ هل صحيح ما يقوله النظام حول تآمر العالم عليه كسبب لتبديل مواقفه منه؟ أم أن العكس هو الصحيح؟ وهو أنه منح فرصا لم تتوفر لغيره من النظم التي سقطت، لكنه ضيعها وأصر على حشر نفسه في فخ الخروج على النظام الدولي ومنظماته، الذي يمكن أن يطبق في أي وقت عليه.
قوض بصورة تكاد تصير تامة الاقتصاد السوري، مع ما تسبب به هذا من إخراج مئات آلاف العمال من سوق العمل إلى سوق البطالة، ومن نقص في مستلزمات وضرورات الحياة، خاصة بالنسبة إلى محدودي الدخل، وهم أغلبية مواطنينا الساحقة، التي شرعت تعاني من جوع لم تألفه من قبل وعلى امتداد تاريخنا الحديث، بينما تتعطل آلة الإنتاج، وتهرب رؤوس الأموال بالجملة والمفرق من البلاد، وتنهار قيمة الليرة السورية، ويعم الفقر، وتختفي الاستثمارات، ولا يبقى من أثر للسياحة، ويدخل القسم الأكبر من الشعب في حالة اكتئاب عميق ممزوجة بقلق مضن على يومه وغده، ويرى المواطن في نفسه مشروعا مشردا أو جائعا أو مقتولا، وفي أولاده وأحفاده مخلوقات لا مستقبل لها، ستكون حياتها أكثر صعوبة بكثير من حياته، التي جعلها النظام حافلة بالهزائم والنكبات والويلات والظلم.
قسم الشعب إلى موالين يرعبهم إحساسهم بالخطر ويدفعهم إلى حمل السلاح والانخراط في العنف، شعورا منهم بأن ظهرهم إلى الحائط أو أنهم أمام هاوية تهدد بابتلاعهم، وأن حياتهم مع أغلبية مواطنيهم لم تعد قابلة للاستمرار وفق معايير المساواة والأخوة والندية والمواطنة والسلام، فلا بد لهم من فرض أنفسهم بالقوة والعنف، وإلا فقبول الموت أو التهجير أو… إلخ. وقسمه بالمقابل إلى معادين هم أغلبية تشعر أنها مستهدفة من عصابات مسلحة تريد إخضاعها بالقوة، ولا ذنب لها غير مطالبتها بما هو من حقها دستوريا وقانونيا ووطنيا، فلا مفر من أن تبادر بدورها إلى حمل السلاح، لقتل عدو انتفت صفة المواطنة عنه، وغابت الجوامع والمشتركات التي كانت تربطها به، بعد أن حول النظام السياسة إلى ساحة عنف يسود فيها الفرز والفصل، وكان يقول حتى الأمس القريب إنها ميدان وصل وتلاق. تبدو سوريا اليوم وكأنه لم يعد فيها شعب واحد متضامن ومترابط، بل جماعات متعادية لم تعد تملك أي لغة تتخاطب من خلالها غير لغة العنف والسلاح! هل سيكون بمستطاع نظام يرجح أن يخرج مهشما من معركته ضد شعبه جبر هذا الشرخ المرعب، الذي يقوض دولة ومجتمع سوريا من الداخل، بينما تسعى قوى دولية وإقليمية كثيرة، أهمها إسرائيل، إلى تقويضهما من الخارج؟ وما الذي سيبقى من سوريا إن كان شعبها يحترب احتراب أعداء، وكانت قطاعات واسعة منه تهجر وتتحول إلى مشردين جياع ومرضى وتائهين في الأقطار المجاورة وداخل وطنها، بعد أن كانوا بالأمس القريب هم الذين يستقبلون المهجرين والمشردين ويكرمون وفادتهم ويقومون بواجبهم، دون فضل أو منة؟
ترى، أي تنمية ستتم بعد المعركة، وأي تحرير، وأي دولة ستبنى، وأي تقدم علمي وتربوي سينجز، وأي بحث سيطور وأي اقتصاد سينمو؟ إن معركة بحجم المعركة السورية الحالية ضد المجتمع والشعب لن تترك فيهما أو في النظام الذي سيدير أمورهما أي قدرة على فعل أي شيء، ولن تكون سوريا عندئذ غير بلد مستضعف ومستعمرة إسرائيلية.
هذه بعض ثمار الحل الأمني، الذي تتسع دوائره وتتصاعد حدته بدل أن يتوقف ويقع التخلي عنه، بعد أن بان فشله منذ أيام تطبيقه الأولى، وبات جليا أن بلدة أو قرية يتم احتلالها واقتحامها عشرات المرات لن تخضع بالقوة، وأن السبيل الوحيد إلى تهدئتها يكمن في تلبية مطالب أهلها. هل فات أهل النظام هذا الجانب؟ وهل فاتهم أن من يهجم بالدبابات على القصير والرستن والمعضمية وكناكر وتلبيسة والحراك والقورية وقلعة المضيق وكفرنبل وحماه وحمص ومئات وآلاف المدن والبلدات والقرى يقدم بنفسه دليل عجزه عن إخضاعها بالقوة، وأن التخلي عن العنف لا يصير في هذه الحالة واجبا وطنيا وإنسانيا فقط، بل الطريقة الوحيدة لإنقاذ أهل النظام أنفسهم وإتاحة فرصة العيش الآمن في وطن أخوة وحب أمام أبنائهم وأحفادهم؟ ألم يفهم هؤلاء بعد هذا الدرس البسيط؟ ألم يدركوا أن طلقات مدافعهم تقتلهم هم بالذات، وأن شعبهم لن يموت؟