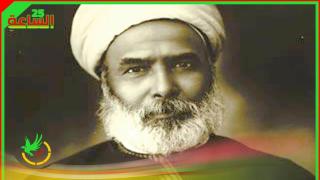ما يحدث في سورية أصبح يعكس وبلا مواربة مثالا حيا إلى أي مدى يمكن أن تصل فيه وحشية ودموية الإنسان. مجازر غير مسبوقة في التاريخ حيث بزت ما سبقها من جرائم إبادة من حيث أساليبها ونهجها ودمويتها وعنفها. وهل بقي لنا من وصف نقوله ما بعد مجزرة التريمسة؟ جز رقاب وقتل أطفال وتشويه جثث واغتصاب نساء وقصف مبان بالطائرات والأسلحة الثقيلة. معجم عفن ممقوت وبغيض مليء بكل ألوان القمع وصنوف الإجرام والتعذيب. نظام مستبد ودموي يقتل شعبه ويجتاح المدن ليحولها إلى مدن أشباح، مكرساً آلة القتل والقهر والتدمير.
وهنا ثمة تساؤل حارق يصرخ من أعماق كل من يشاهد مسلسل الموت الدامي اليومي: تُرى أين صحوة الضمير العالمي،والى متى يستمر هذا الصمت المريب الخانع، وذلك التردد المفضوح؟
وهل من المعقول أن مجلس الأمن، الذي يفترض أن تقع عليه مسؤولية ترسيخ الأمن في كوكبنا، لم يستطع إلى هذه اللحظة من الاقتراب لإصدار قرار تحت الفصل السابع بسبب التواطؤ الروسي والصيني؟
أليست كافية تلك الأكوام من الجماجم والجثث والمناظر البشعة،التي لايمكن لكائن بشري من تحملها، بأن تُفيق الضمير العالمي من سباته وتصيبه بقشعريرة الخزي والعار ليبادر بإيقاف آلة القتل؟ وأين تلك الدول التي ما فتئت تتشدق بحماية حقوق الإنسان أمام تلك المشاهد الإجرامية؟ وهل ذهبت أدراج الرياح كل تلك القوانين والمواثيق الدولية والالتزامات الأدبية والأخلاقية التي وضعها المشرعون لحماية الشعوب؟!
لقد كان محقاً خادم الحرمين الشريفين عندما طالب بإصلاح الأمم المتحدة، التي تجاوز عمرها الستة عقود، معلقاً الجرس حول مستقبل المنظمة العتيقة لاسيما وان أقواله أكدت اهتزاز الثقة بها،لافتا إلى ان العالم لا يحكمه عدة دول بل يُحكم بالعقلانية والإنصاف والأخلاق.
ولعل الموقف الذي نراه في سورية الآن يعطي زخما لانتقاد الملك حول أهمية إعادة النظر في هيكلية الأمم المتحدة ودور مجلس الأمن وآلية اتخاذ القرار فيه،كونه يطالب بإصلاح جذري يعالج الجوهر لا الشكل. وينشط الذاكرة الإنسانية في أن الغاية من إنشائها تكمن في حماية الأفراد والشعوب وليس مؤسسات الدول التي تفتك بشعوبها. بمعنى آخر أن مفهوم الأمن الإنساني هو حماية الأفراد داخل الحدود وليس فقط امن الحدود.
على أن التذمر يأتي عادة بسبب آلية العمل الإجرائية في المنظومة الأممية،وابرز مثال على ذلك نظام الفيتو الذي بات يُستخدم كأداة صراع وهو ما يتعارض مع نص صريح في ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص صراحة على “مبدأ المساواة بين الأعضاء”. ناهيك عن تعطيل بعض القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لتأثره بموازين القوى ومفاعليها، بدليل الفيتو الروسي- الصيني الذي جاء كترجمة واقعية لهذا الخلل ما يعني أن القواعد المرجعية التي يستند إليها مجلس الأمن تفتقر إلى الوضوح.
مع أن ميثاق الأمم المتحدة جعل مهمة تولي تبعات اختلال الأمن والسلم الدوليين لمجلس الأمن وذلك وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق والتي تجيز له استخدام القوة عند الضرورة، وهي استثناءات كحالات الدفاع عن النفس، كما يحدث الآن في سورية،لكن تبقى هناك إشكالية التطبيق وتداخل المصالح.
وإذا كانت روسيا وإيران والصين شركاء في جريمة العصر، فان ذلك قطعا لا يعفي الغرب من تحمل المسؤولية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، فالتلكؤ والخذلان فضلا عن البيانات المكرورة التي لم تعد تجدي،كلها باتت تُصيبنا حقيقة بالاشمئزاز والتقزز والقرف، بدليل المجازر المروعة التي نشاهدها تُرتكب يوميا وقد وجدت لها مسوغا شرعيا لشراء الوقت من خلال المُهل الزمنية التي استفاد منها النظام السوري أيما استفادة في المماطلة والتسويف!
إن المتابع للتصريحات الغربية يشعر بأنها ما هي إلا ذر الرماد في العيون،أو بمعنى أدق إعطاء ضوء اخضر للنظام السوري للمضي قدما في دمويته وهمجيته. هذا عدا أن بقاءه يعني دخول دول الإقليم في نفق الفوضى والانتقام من قبل دمشق وهذا بمثابة إشعال لصدامات وصراعات ومماحكات، ولذا فإسقاطه بات ضرورة لأمن شعوب المنطقة.
إن دمشق تعرف أبعاد اللعبة، وتجيد فنونها مع حليفتها طهران،وقد استماتتا كما نلمس محاولتين توسيع نطاق الصراع وتوريط دول أخرى في المواجهة. فدمشق على يقين بأن سلوكها الدموي هو بمثابة انتحار سياسي، وان النتيجة ستؤدي إلى أفول النظام في نهاية المطاف،ومع ذلك تشعر بأن الهروب إلى الإمام وشراء الوقت هما المخرج الأخير لأنه لم يعد بيدها حيلة، معولة على تحولات سياسية أو ربما متغيرات دولية قادمة.
على أن عدم حماس الغرب لمسالة التدخل العسكري في سورية، كما يبدو لانشغال البيت الأبيض بالانتخابات، ولقناعتهم بعدم وجود بديل،وكذلك خشيتهم من انتماءات الثوار السوريين، التي قد تصل للحكم وهي مناهضة للسياسات الغربية فضلا عن ضغوط تل أبيب في أفضلية بقاء النظام الحالي. ناهيك عن الاصطفاف بين معارضة الداخل والخارج. كما أن هناك من أبدى خشيته من مواجهة أميركية-روسية، وذلك بأن يتحول التراشق السياسي فيما بينهما إلى مواجهة عسكرية في أية لحظة، فالأسطول الروسي في طرطوس والقوات الأميركية متواجدة في الجهة المقابلة.
صفوة القول، طالما أننا لا نعول على تغير الموقف الروسي، فالمؤمل من الغرب-إن ارتهن للمنطق والحق والواجب-أن يتمسك بمبادئه في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب ولو بالقوة إن وجب الأمر كما فعلها من قبل في كوسوفو، فحماية الشعوب من الفتك بها تستوجب التدخل ولو بشكل انفرادي وذلك من باب ترسيخ الأمن الإنساني. فالحل يجب أن يأتي ولا يهمنا أن يكون على شاكلة الأزمة الليبية أو أسلوب النموذج اليمني، بقدر ما أن المهم هو إنقاذ الشعب السوري من مسلسل الإبادة. فهل يصحو الضمير العالمي وينتصر للعدالة والحرية والكرامة الإنسانية؟
سؤال ربما يرهقه انتظار الإجابة..!!