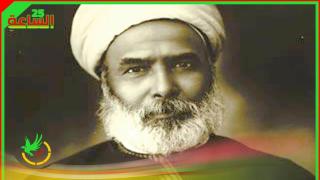إذا كان حملة الفكر الليبرالى من مواطنات ومواطنى البلدان العربية قد شاركوا بفاعلية فى الانتفاضات الشعبية عامى ٢٠١٠ و٢٠١١ وأسهموا فى صياغة المطالب الديمقراطية الأساسية
إذا كان حملة الفكر الليبرالى من مواطنات ومواطنى البلدان العربية قد شاركوا بفاعلية فى الانتفاضات الشعبية عامى ٢٠١٠ و٢٠١١ وأسهموا فى صياغة المطالب الديمقراطية الأساسية رابطين بين الحريات وحقوق الإنسان وبين التخلص من الاستبداد وإنفاذ حكم القانون والتداول السلمى للسلطة، فإن صيرورة «ما بعد الانتفاضات» لم ترتب إلى اليوم سوى الإبعاد الممنهج لليبرالية عن مراكز صنع القرار السياسى وإغراق بلادنا فى متواليات ظلم ودماء بائسة أطرافها ديكتاتوريات مجرمة وسلطويات جديدة وعصابات إرهاب وتطرف. لم تأت رياح «الربيع العربى» بما اشتهته سفن الليبراليين إن من إقرار الحريات الشخصية والعامة ومواطنة الحقوق المتساوية دون تمييز، أو من التوافق على منظومات عصرية لمجتمعات عمادها صون حقوق الأقليات وقيم التسامح والعيش المشترك وإطلاق حرية المرأة والتنظيم الطوعى ومبادرات القطاع الخاص وأدوات العدالة الاجتماعية ولحكومات تقبل مبادئ الرقابة والمساءلة والمحاسبة والفصل بين الدين والدولة وتداول السلطة عبر صندوق انتخابات نزيه لا يزج إلى داخله بالهويات الدينية والعرقية والقبلية.
لم يكن إخفاق الليبراليين ناجما فقط عن جبروت قوى الديكتاتورية والسلطوية والإرهاب، تلك القوى التى يسيطر اليوم قديمها وجديدها، ملوكها ومماليكها، أمرائها وعسكريوها، عصاباتها ومجرموها على شئوننا ونتقلب معهم بين شىء من الرخاء الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى نظير التنازل عن الحريات الشخصية والعامة، وبين رخاء واستقرار غائبين وسحق دائم للحريات والحقوق باسم وعود مخادعة بالأمن والأمان، وبين انتهاكات لحقنا المقدس فى الحياة يتورط بها إرهابيو عصابات الفاشية المتأسلمة وإرهابيو حكومات الفاشية الأمنية. لم يكن إخفاق الليبراليين ناجما فقط عن جبروت تلك القوى، بل سببه أيضا تفتت المجموعات الليبرالية وضعفها التنظيمى وتخاذلها السياسى ووهنها فيما خص التمسك بمبادئها الكبرى دون مساومة.
ساوم بعضنا على الديمقراطية قيما وآليات حين جاءت الانتخابات فى بلد كمصر بانتصارات متتالية للإسلام السياسى، وتنادى لمطالبة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للإجهاز على تجربة التداول السلمى للسلطة لاستبعاد من فازوا انتخابيا دون انتظار لتجدد الاحتكام للصناديق أو إصرار على تبكيرها بضوابط ديمقراطية، وأيد إسقاط مشبوه للمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، وبرر لانتهاكات مفزعة لحقوق الإنسان تارة صراحة وتارة ضمنا ولم يستفق إلا حين طالت جرائم القتل خارج القانون والاختفاء القسرى والتعذيب من ينتمون لغير الإسلاميين وبات مستحيلا إنكار طبيعتها الممنهجة. ساوم بعضنا الآخر على الإقرار الشامل للحريات الشخصية، وقبل العصف المستمر بحريات النساء والمثليين جنسيا فى خنوع وخوف بينين، وامتنع عن الانتصار الصريح للحق فى حرية الاختيار فى الحياة الخاصة كما فى الحياة العامة دون اضطهاد أو تمييز (ولم يكن فى تلاعبى بقضية الحق فى الزواج المدنى فى مصر بعد أن طرحتها علنا فى ٢٠١١ وتراجعت عنها خوفا غير تعبير ردىء عن مثل تلك المساومة غير الأمينة على الحريات الشخصية).
بعضنا الثالث ساوم على مبدأ الفصل بين الدين والدولة بصياغات دستورية وقانونية وسياسية تلفيقية، فصمت على نصوص دستورية تحدد للدول دينا، وقبلت نصوصًا قانونية تميز ضد غير المسلمين فيما خص الحرية الدينية وضد النساء فيما خص المعاملات الشخصية كالزواج والطلاق والمواريث، ورحب بتورط المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية فى السياسة حين خاصمت قوى الإسلام السياسى وتحالفت مع الأحزاب الليبرالية واليسارية. أخيرا، ساوم البعض كما فى الحالات السورية والليبية واليمنية على الرفض القاطع لعسكرة الانتفاضات الشعبية وانفتح فى مواجهة عنف حكومات ديكتاتورية أو جرائم ما تبقى من مؤسسات استبداد وقمع على اقتراب من قوى معارضة لا تقل تورطا فى العنف والاستبداد والقمع، وهو ما زج (من بين عوامل أخرى) بالبلدان الثلاثة إلى أتون حروب أهلية ومواجهات عسكرية وفوضى شاملة لم تنحصر إلى اليوم.
عربيا، أسقطت هذه المساومات الفكرة الليبرالية فى هوة سحيقة من فقدان مصداقية المتحدثين باسمها ومن ضياع هوية مبادئها الكبرى وملامحها الأساسية التى لم يعد لا الخواص ولا العوام يدركون خطوط بداياتها وتخوم نهاياتها.
***
لم يعد بفرية أن تصنف الأغلبية الساحقة من الليبراليين المصريين وأحزابهم كمرتمين فى أحضان المؤسسات العسكرية والأمنية، ومبررين للسلطوية الجديدة التى تقمع المواطن وتغلق الفضاء العام وتحارب المجتمع المدنى وتستتبع المؤسسات المدنية للدولة (كالقضاء والبرلمان والهيئات الرقابية) وتزيف وعى الناس بإعلام لا يتوقف عن الترويج لنظريات المؤامرة وحملات لتشويه أصوات الحرية وعن نشر الأوهام التى تسمى اليوم الحقائق البديلة. ولم يعد مستهجنا أن يشار إلى العدد الأكبر من الليبراليين التونسيين كمتحالفين مع بقايا حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، دون اعتبار لشبهات التورط فى انتهاكات حقوق الإنسان بالماضى القريب أو فى فساد الأمس واليوم أو فى العداء الصريح للمطالب الديمقراطية المرتبطة بالتخلص من القوانين الاستثنائية والكف عن وضع العراقيل أمام تجربة العدالة الانتقالية الرائدة. ولم يعد مستغربا أن يرمى جل الأحزاب الليبرالية فى المغرب بالاستعلاء على منظمات المجتمع المدنى المتمسكة بإقرار كامل الحريات والحقوق الشخصية وبالتنازل لحسابات سياسية ضيقة عن مطالب التقييد الدستورى لدور المؤسسة الملكية فى الحكم ولتدخلاتها المستمرة فى أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومحاربة فساد النخب المتمتعة تقليديا بالحماية الملكية، والدفاع عن حرية الصحف ووسائل الإعلام التقدمية حين تواجه التوظيف السياسى للدين من قبل المؤسسة الملكية وحلفائه الجدد فى الأحزاب الإسلامية. ولم يعد مدانا لا أخلاقيا ولا سياسيا وعلى الرغم من الجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها بقايا الحكومات فى سوريا وليبيا واليمن بمساعدة إقليمية ودولية، أن تنتقد بعض المجموعات الليبرالية التى رفعت فى بدايات الانتفاضات الشعبية لواء مطالب التحول الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة وحكم القانون ومواطنة الحقوق المتساوية دون تمييز طائفى وباتت اليوم فى معية اقتراب مشبوه من حملة السلاح وممارسى العنف ومروجى الطائفية والتطرف.
فقط فى بعض مساحات المجتمع المدنى ما زال للفكرة الليبرالية حظوظا من المصداقية ووضوح الملامح والجاذبية؛ تحديدا فى أوساط منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وقضايا المرأة والحريات الصحفية والإعلامية، وبين التنظيمات المهنية والنقابية المتمسكة بحرية التنظيم، وبين بعض القطاعات الطلابية فى الجامعات الحكومية والخاصة التى تنتشر على دروبها الدعوة للحق فى الاختيار وللحريات الشخصية والعامة فى سياق علمانى وديمقراطى، وبين شباب المبدعين من مسرحيين وموسيقيين ورسامين وسينمائيين وأدباء الذين يجدون فى شبكات التواصل الاجتماعى والإعلام البديل.
بعبارة أخرى، كلما ابتعد دعاة الليبرالية فى المجتمع المدنى عن الحياة السياسية الرسمية وعن دوائر الحكم والمعارضة وعن الإعلام التقليدى كلما نجت أصواتهم ومطالبهم وإبداعاتهم من هوة فقدان المصداقية وضياع الهوية التى فرضتها أغلبية ليبراليى الربيع العربى على الفكرة وعليهم. وإليهم، إلى ليبراليى المجتمع المدنى، يئول حمل إخراج الليبرالية العربية من هوة الربيع السحيقة.
أسحيقة من فقدان مصداقية المتحدثين باسمها ومن ضياع هوية مبادئها الكبرى وملامحها الأساسية التى لم يعد لا الخواص ولا العوام يدركون خطوط بداياتها وتخوم نهاياتها.
بقلم: عمرو حمزاوي
المصدر: بوابة الشروق
(هذا المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع)