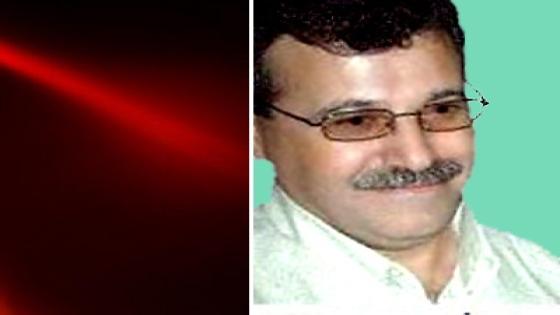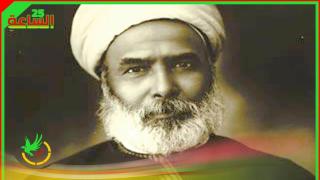بقلم: أكرم البني
بقلم: أكرم البني
ترتفع في هذه الآونة حرارة الحديث عن مخاوف الأقليات في سوريا، قومية كانت أم دينية، وعن حقيقة مواقفها من الثورة، ربطاً باحتدام الصراع السياسي والعسكري ووصوله إلى محطات خطيرة، وبالتحسب من وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم، والخشية من مظاهر التضييق والتنميط المرافقة لهذا النوع من الحكومات، التي تحاول فرض أسلوب حياتها وثقافتها على المجتمع، وتهديد هوية هذه الأقليات وحقوقها وطرق عيشها.
تشكل الأقليات الإثنية والدينية في سوريا نسبة تصل لأكثر من 40% من عدد السكان، وتتألف من شتى مذاهب المسلمين والمسيحيين وقوميات تتباين ثقافاتها مع العرب، كالأكراد والشراكس والتركمان والأرمن والآشوريين، وقد شاركت جميعها في التحرير والاستقلال وبناء دولة وطنية جامعة وأيضاً في التعرض لمختلف أصناف القمع والاضطهاد من النظام الحاكم بغية تطويعها وتسخيرها لخدمة مصالحه ولتوسيع قاعدته الاجتماعية، وإذ لازمت في غالبيتها الصمت والخضوع لإملاءات السلطة خلال عقود طويلة تحت هواجس شتى، لكن تاريخها شهد حركات ونشاطات مناهضة لسياسات الاستبداد من خلال أحزاب وشخصيات معارضة عانت من السجون والإفقار والمنافي.
وعرف المشهد السوري معارضين أكرادا قاوموا ببسالة سياسات التهميش والتمييز العنصري وأيضا قمع المئات من المعارضين السوريون من الإسماعيليين والدروز والعلويين والمسيحيين، لقاء دعوتهم لبناء سوريا مدنية تعددية وديمقراطية.
وطبعاً ما كان لينتشر في سوريا مصطلح أقليات وأكثرية، لولا تواتر حالات التمييز السلطوي، القومي أو الطائفي، لضمان الولاء على حساب الرابطة الوطنية والسياسية وعلى حساب معايير الكفاءة والنزاهة، ولولا استجرار وتشجيع ردود أفعال وولاءات من الطبيعة ذاتها لدى تلك الكتل الاجتماعية، قبل ذلك كان السوريون، على اختلاف انتماءاتهم يشكلون نسيجاً اجتماعياً واحداً، ويتعايشون في إطار وحدتهم الكيانية والسياسية ويتشاركون بشكل طبيعي، ودون أية تفرقة، في أنشطة الحياة وتنمية المجتمع وبناء الدولة، ونهضت من منابت متنوعة شخصيات وأسماء وطنية خاضت المعارك ضد الاحتلال الفرنسي واحتلت مناصباً سياسية وعسكرية عليا، كإبراهيم هنانو وصالح العلي وسلطان باشا الأطرش وأيضاً فارس الخوري وفوزي السلو وسعيد إسحاق وحسني الزعيم وأديب الشيشكلي وغيرهم.
لقد لعب السوريون، من مختلف المكونات القومية والدينية، دوراً متكاملاً في بناء دولتهم الحديثة وتاريخهم المعاصر، وشكلت عندهم قيم المواطنة والمساواة قاسماً مشتركاً، ولنقل غلب في مراحل المد الوطني والقومي انتماؤهم إلى الأحزاب الحداثية على أي انتماء.
وإذا أخذنا في الاعتبار ما تعرض له الكرد السوريون من اضطهاد وتمييز شجع ولادة أحزاب كردية تنافح ضد الاضطهاد القومي وأيضاً التباسات المعركة طائفياً التي شهدتها البلاد بين الإخوان المسلمين والسلطة في مطلع الثمانينيات، يصح القول إن مشكلة الأقليات والأكثرية في سوريا وقفت غالباً، ومن حسن الحظ، عند حدود الاستئثار بتوزيع المناصب والامتيازات ولم تتحول إلى تعبئة سياسية تخوض الصراعات وفق مشاريع فئوية خاصة وتالياً إلى تخندقات متخلفة خطرة، مشحونة بالإقصاء المتبادل وبرغبة عمياء في إضعاف الآخر والنيل من قوته وحقوقه على حساب الهم الوطني العريض.
وبخلاف بلدان مجاورة كلبنان والعراق، هناك أسباب موضوعية وبنيوية في سوريا لغلبة مسار الانصهار الوطني في مواجهة نوازع التفرقة والتمييز، فالمجتمع لا يملك رصيداً من الأحقاد والمواجهات الحادة بين مكوناته يستحق التوظيف والاستثمار، ثم أن درجة الوعي العام لدى الشعب السوري والتفافه المزمن عبر أحزاب سياسية متنوعة حول مهام وطنية وقومية عريضة ثم حول السحر الاشتراكي تركت آثاراً إيجابية على تضامنه ووحدته واندماجه، وأضعفت تالياً البنى العصبوية التقليدية وإمكانية تبلورها في مشروع سياسي خاص كما ساعدت في تمكين بناء دولة وطنية نأت عن المحاصة السياسية الطائفية.
وإذا أخذنا في الاعتبار إلى جانب ذلك أهمية التداخل الجغرافي بين مكونات المجتمع المختلفة وندرة وجود معازل أو أماكن نقية تحسب على أقلية أو أكثرية، وأضفنا أن الأكثرية، حالها كحال الأقليات، ليست موحدة ثقافياً أو سياسياً، فما يجمعها هو الرابط الديني وإيمانها العفوي التقليدي، لكن تفرقها اجتهادات متنوعة في فهم علاقة الدين بالحياة، كما انتماءاتها المختلفة، إلى أطر وجمعيات اجتماعية وسياسية، منها الليبرالي والقومي والشيوعي ومنها ما يدور في فلك السلطة ويجد مصالحه في مساندتها ودعمها.
وإذا أضفنا أيضاً أن الثورة السورية التي تنتمي كتلتها الرئيسة بداهة إلى الإسلام بصفته دين الأغلبية، تنطوي على تنوع وتعددية لافتين، فإلى جانب العرب والأكراد والشراكسة والتركمان والآشوريين، هناك مشاركة متفاوتة تبعاً لكل منطقة من مختلف الطوائف والمذاهب، والأهم أنه لم تسمع أصوات إسلامية وازنة تدعو إلى إقصاء الآخر دينياً أو إلى حكم الشريعة ودولة الخلافة، بل غلبت على هتافات المحتجين الشعارات المناهضة للطائفية وإعلاء قيم المواطنة وأسس العيش المشترك، عززتها وثيقة العهد الوطني التي طرحها الإخوان المسلمون حول مستقبل البلاد ولاقت ارتياحاً كبيراً لدى الأقليات ومختلف القوى والفعاليات.
وإضافة لما سبق، فثمة أسباب ذاتية ضرورية لتمكين المسار الوطني تزداد حضوراً وإلحاحاً طرداً مع هذا التوغل المريع في القمع والتنكيل ضد المحتجين، وإصرار أهل الحكم على إظهارهم كأدوات تآمرية وطائفية، منها التأكيد على عمومية الحقوق في الحرية والكرامة التي تطالب بها الثورة السورية والتي أعاقت ذهاب الاصطفافات إلى مكان خاطئ وإلى صراعات فئوية مدمرة، ومنها أولوية تمسك الجميع بضرورة الحفاظ على الدولة ودورها ومؤسساتها العمومية.
فتغيير السلطة يجب ألا يقود إلى تفكيك الدولة أو الإطاحة بمؤسساتها وبدورها كمحتكر للسلاح وكعصب أساسي لحماية المجتمع، ومنها الارتقاء بدور المعارضة السياسية ووحدتها وقدرتها على تمثيل مختلف القوى والفعاليات بعيداً عن المحاصة والحسابات الضيقة، والأهم تشجيع المبادرات لتشكيل لجان أهلية مناهضة للطائفية والتمييز كما شهدنا في بعض المناطق والأحياء المختلطة، تعزز أسس التعايش والتسامح والتكافل وتساهم في حماية أرواح الجميع وممتلكاتهم ومحاصرة نوازع التفرقة والتمييز على أسس قومية أو طائفية أو مذهبية.
وإذ نعترف أن مسألة الأقليات ومخاوفها هي شماعة يستخدمها المتمسكون بمصالحهم ليبرروا سلبيتهم وصمتهم ويستخدمها المجتمع الدولي ليبرر تخاذله ويستخدمها النظام ليتوغل أكثر في القمع والتنكيل، نعترف أيضاً بأن مخاوف بعض الأقليات من التطرف الإسلامي هي مخاوف حقيقية يجب معالجتها عبر خطوات جرئية لسحب البساط من تحت أقدام من يصورون السلطة بأنها حامية الأقليات.
وبهذا الصدد لا يمكننا لوم هذه الجماعات على خوفها وإحجامها، أو معالجة الخوف بالإدانات والشتائم، بل بالإقدام الشجاع لتجاوز العوائق التي تمنع التواصل بين الأقليات وبين المعارضة والناشطين الميدانيين، وإزالة الصور الشريرة التي يروج لها عن الثورة استناداً إلى أفعال قامت بها بعض المجموعات المسلحة وإلى تقارير صحفية أجنبية عن الآخر الديني الذي لا يمتلك خياراً سياسياً بل ميلاً للقتل والتنكيل والانتقام.
وبالتالي، وبرغم مشاركة بعض الجماعات من الأقليات السورية في الثورة ولو بنسب متفاوتة، إلا أننا نشهد قلقا وخوفا لديهم من مرحلة ما بعد النظام، يزداد مع ظهور خطابات حول أسلمة الثورة وممارسات إقصاء وتهميش من بعض المعارضين، بل ويدفع البعض موقفه إلى حد القول بأن ثمة من يتقصد تهميش دور الأقليات لإعطاء الثورة السورية بعداً وشكلاً إسلاميين، دون أن يهتم بأن يلتقي مقصده مع محاولات النظام تعميم فكرة إسلامية الثورة وحضور القاعدة وأخواتها كي يخفف الضغوط الخارجية ويضمن استمرار ولاء قطاعات كبيرة من الأقليات أو وقوفها على ضفة الصمت، وبخاصة الفئات التي تتقارب في نمط عيشها مع الوضع القائم ليدعي أنه يتحدث ويحارب باسمها، لنجد علاقة هذه الأقليات بالثورة كأنها تدور في حلقة خطيرة، فتنامي العنف والميل الإسلامي في الثورة السورية إذ يعزز من مخاوف أبناء الأقليات فإن خوف هؤلاء وإحجامهم عن المشاركة يعزز بدوره من إسلامية الحراك ويغذيه ببعد طائفي ليعود ويغذي تلك المخاوف من جديد.
لم تكن الثورة السورية من صنع أحد، بل هي، وباعتراف كل القوى السياسية، انتفاضة شعبية عفوية نهضت من معاناة أجيال جديدة من الشباب المهمش، بعيداً عن الأطر الحزبية والأيدولوجيات الكبرى وشعارات الهوية، لكن الوزن الشعبي اللافت للإسلاميين في هذه الثورة، كتعويض ربما عن اضطهادهم المزمن، يرشحهم للعب دور مهم، في قيادة المرحلة الانتقالية، وإذا كان مطلب الدولة المدنية التعددية والديمقراطية هو مطلب مشترك للجميع، وأن الجماعات الإسلامية التي نصبت من نفسها وكيلاً عن شؤون الأكثرية، لا تمل من تقديم الوعود والضمانات للأقليات وطمأنتها على حقوقها واحترام خصوصياتها، فإن عليها أيضاً بذل جهود خاصة لإزالة الشكوك والارتياب حول صدقيتها وبأنها تضمر غير ما تظهر ولن تفي بما تعد به، خاصة وإنها ليست قليلة التجارب التي يمكن أن يستند إليها الكثيرون للطعن بوفاء هذه القوى.
والحال، يقع على عاتق الحركات الإسلامية المعارضة مسؤولية خاصة لنيل ثقة مجتمع تعددي ومتنوع، ليس فقط في تظهير دورها المدافع عن حقوق المواطنة والدولة الديمقراطية، وإنما في تبديل الصورة النمطية عن نكوص الأحزاب السياسية وجماعات الإسلام السياسي عموماً بوعودها والانقلاب، ما إن تتمكن، ضد الحريات وتداول السلطة، والأهم إشهار موقف واضح من شعار الدولة المدنية يزيل ما يكتنفه من التباسات، فالدولة المدنية ليست شعاراً التفافياً يقتصر على إبعاد رجال الدين والعسكر عن الحكم، وإنما هي الدولة التي تحافظ على استقلال السلطة في التشريع وإدارة الحكم، وتقف على مسافة واحدة من كل مواطن، بغض النظر عن جنسه أو دينه أو معتقده.
والخلاصة، لا خوف على الأقليات في سوريا، لكن من لا يحضر السوق لا يبيع ولا يشتري، وبالتالي لا معنى للقول بمستقبل أفضل وآمن للأجيال القادمة وبدعم الديمقراطية وحقوق المواطنة إذا لم تنخرط مختلف مكونات المجتمع السوري في التغيير وفي عمليتي الهدم والبناء، فالخلاص مما نحن فيه لا تصنعه الدعوة للحفاظ على الوضع القائم بل نقضه، مثلما لا يحققه تسويغ الموقف المحايد أو الخائف والمتردد للأقليات واستسلامها لتشويش ومبالغات مغرضة في قراءة أحوال الثورة الناهضة، بل في هذا ما قد يطيل فترة المخاض ومعاناتها وآلامها.
إن مشاركة الأقليات في الثورة هي أحد العوامل المسرعة في إسقاط النظام وضمان صحة التغيير وتثبيت حقوق المواطنة المتساوية بين الناس دون النظر إلى عقائدهم أو انتماءاتهم أو منابتهم، ومن هنا تقتضي الضرورة توفير ضمانات لحقوق الجميع، لكي يندفعوا بحيوية أكثر في مسار الثورة السورية ويكونوا شركاء حقيقيين في تقرير مستقبل البلاد وذلك بتوثيق كافة حقوق هذه الأقليات في وثيقة وطنية يتعهد الجميع بصيانتها وتضمينها ضمن الدستور الوطني وبإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بحيث يتمتع الجميع بكافة الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية وفق الإعلان العالمي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان منعا لعودة الاستبداد، وكسرا لنظرية حق الأغلبية في السيطرة ورضوخ الأقلية لها.