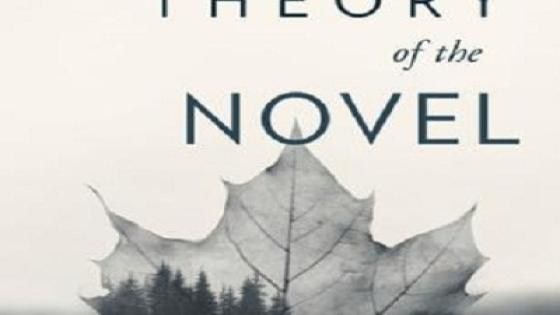تقيّم هذه الورقة عملية تشكيل الائتلاف، وتحاول الإجابة عن سؤال: هل يشكّل هذا الائتلاف الجديد نقلة نوعيّة في تمثيل الثورة السوريّة سياسيًّا؟
الطريق إلى الائتلاف:
قدّمت الثورة السوريّة نموذجًا مختلفًا عن الثورات التي انطلقت في العالم العربيّ منذ عام 2011 في كثير من المجالات. ويعبّر الجانب المتعلق بالنشاط والفعالية السياسيّة للمعارضة عن أحد جوانب هذا الاختلاف، لا سيما حقيقة أنّ الوجوه السياسيّة للثورة يتركز معظمها خارج سورية.
نشأت هذه الخصوصية من تضافر عوامل مختلفة، على رأسها إحكام النظام قبضته على الحياة السياسيّة وغياب أي هامش للعمل السياسيّ، فحُوصرت القوى السياسيّة المعارضة داخل سورية وعُزلت بالقمع والتخويف، وجرى تقليص تأثيرها قبل اندلاع الثورة، فأصبح هامشيًّا ومقتصرًا على بعض الأوساط الاجتماعيّة المحيطة بالمعارضين مباشرةً، آخذًا بذلك شكل نوع من الثقافة الفرعية.
وفي غياب فاعلية القوى السياسيّة المعارضة المنظَّمة وانحسارها، كان على السوريّين بعد انطلاق الثورة أن يُعيدوا إحياء القوى السياسيّة المنظَّمة القليلة القائمة، وأن يعملوا خلال الثورة على بناء أُطرٍ وقياداتٍ سياسيّةٍ تعبّر عن هذه الثورة في الوقت ذاته. ولا شك في أنّ شباب القوى الحزبيّة التقليديّة وقواعدها كان لهم دورٌ مهمٌ في الحراك الثوريّ المدنيّ في البداية. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أنّ أغلب القيادات السياسيّة لجأت إلى الخارج تجنبًا لقمع النظام، أو بهدف الحصول على حريةٍ أكبر في العمل، تمكّنها من اتخاذ مواقف سياسيّة أكثر وضوحًا والتعبير عنها في خضم الثورة.
لم تنجح القوى السياسيّة المعارضة – في البداية – في تشكيل هيئات تنظيميّة جامعة لقيادة الثورة نتيجة تبايناتها السياسيّة واختلافاتها الفكريّة والأيديولوجيّة، وكذلك لأسباب متعلقةٍ بالذاتويّة والتنافس الشخصيّ. لقد كشف رفع غطاء الاستبداد الكثير من عيوب المجتمع الذي يعيش منذ سنوات طويلة في ظله، وظهرت معالم ثقافة الاستبداد في سلوكيات أوساطٍ من المعارضة.
وبعد نصف عام على اندلاع الثورة، مثّل تأسيس المجلس الوطنيّ (تشرين الأول / أكتوبر 2011) أول محاولةٍ جدّية لتشكيل هيئةٍ جامعةٍ تكون الوجه السياسيّ للثورة، وتحظى باعترافٍ دوليٍّ كبير. لكن آلية عمل المجلس المؤسسة على قاعدة التوافق والتوازنات والمحاصصة بين كُتلِهِ (الإخوان المسلمون، إعلان دمشق، مجموعة العمل الوطنيّ، المستقلون) ثبّطت عمله، ومنعت توسيعه، وأعاقت التنسيق الجدّي والفاعل مع أطياف المعارضة الأخرى. كما عجز المجلس عن مواكبة التغيّرات المتسارعة في مسار الثورة، لا سيما عندما تحوّلت إلى ثورةٍ مسلحة، إذ لم يتمكن من تلبية متطلبات هذه التطورات، خاصة في الجانب العسكريّ والإغاثيّ، وهو ما أوجد هوّة بين قياداته و تطورات الداخل السوريّ. وفي وقت تواصلت فيه المناشدات الدوليّة للمعارضة بتوحيد صفوفها، ساهمت الدول ذاتها في إضعاف المجلس، وأعاقت وحدة المعارضة بإصرارها على الاتصال بالقوى الثوريّة على الأرض مباشرة من دون المرور بأيّ هيئة قياديّة. وتفاقم هذا النهج مع انتقال الثورة إلى الكفاح المسلح، إذ ربطت القوى الخارجيّة الاتصال مع الكتائب على الأرض مباشرةً، ما منع عمليًّا تشكيل هرميّة قياديّة سياسيّة تربط قوى الثورة بأيّ قيادة سياسيّة على المستوى الوطنيّ.
ومن ناحية أخرى، ارتكبت قوى المعارضة المختلفة أخطاء في تحديد الإستراتيجيّة، لأنّها قامت على التحليل الرغبويّ، أو البيان الشعبويّ، وليس على تحليلٍ واقعيٍّ للحقائق. فقد أيّد تيارٌ في المعارضة السياسيّة الحوار مع النظام بدايةً، ليس بأي ثمن، وبشرط التغيير، معتقدًا أنّ الحوار قد يكون هو الطريق لتغيير النظام. وراهن تيارٌ آخر في المعارضة عمليًّا على التدخل الخارجيّ. وقد فشل التياران في تشخيصهما، وأدركا ذلك بعد أن تحوّلت الثورة المدنيّة عفويًّا إلى الكفاح المسلح بسبب تعرضها إلى قمعٍ غير مسبوق. وقد استغلت قوى سياسيّة دينيّة متطرفة قائمة هذا التحوّل إلى العنف بشكل غير منظم، لكي تفرض أجنداتها القديمة المعروفة والتي ما كانت لتنجح في قيادة ثورة في سوريّة في يوم من الأيام. ولا تزال هذه القوى تشكّل أقلّيةً في الشارع السوريّ حتى اليوم.
جاء مؤتمر القاهرة يومي 2 و3 تموز / يوليو 2012 كمحاولةٍ جدّيةٍ لتجاوز الواقع السابق برعاية الجامعة العربيّة. وقد استطاعت المعارضة السوريّة (باستثناء المجلس الوطنيّ الكرديّ) توحيد رؤيتها السياسيّة والمستقبليّة في وثيقتي “العهد الوطنيّ” و”المرحلة الانتقاليّة”. وجرى تشكيل لجنة متابعةٍ تتولى تنسيق مساعي المعارضة السوريّة، إلا أنّ عقلية المحاصصة، والبحث عن تعظيم المكاسب الحزبيّة والسياسيّة على حساب العمل الوطنيّ الجمعيّ، واحتكار بعض قوى المعارضة التمثيل والشرعية، أبقت على حالة الانقسام.
وأصبح هذا الانقسام مأزقًا لقوى المعارضة المختلفة، وسحبت فوضى العمل المسلح في الداخل من القوى الميدانية إمكانية تشكيل ضغط حقيقيّ على المعارضة لتوحيد صفوفها. فقد غذّى التشتت الداخليّ الانقسام السياسيّ والتنظيميّ في الخارج، والعكس صحيح.
أدى هذا الواقع إلى ظهور عدة مبادرات سياسيّة لتوحيد المعارضة في الأشهر الماضية، كان من أبرزها مبادرة الدكتور برهان غليون لإقامة لجنة مبادرةٍ وطنيّةٍ من شخصياتٍ وطنيّةٍ مُتوافَقٍ عليها، تقوم بتعيين حكومةٍ مؤقتة لملء الفراغ السياسيّ. وقد تحوّل النقاش بشأن الحكومة المؤقتة وكيفية تشكيلها إلى نقاشٍ يشغل المعارضة، فاقترح البعض أن يشكّلها المجلس الوطنيّ. كما طرح النائب السابق رياض سيف مبادرةً لتجاوز المجلس الوطنيّ. وجاءت هذه بعد انتقادات علنيّة وجهتها الإدارة الأميركيّة للمجلس، وذلك باقتراح إيجاد هيئةٍ سياسيّة مصغّرة تضم القوى السياسيّة في المجلس الوطنيّ وتكتلات المعارضة الأخرى بحيث تستطيع تجاوز حصرية تمثيل المجلس التي أعاقت الاتفاق في جولات التفاوض السابقة. وقد شكّلت هذه المبادرة التي اصطلح على تسميتها “هيئة المبادرة الوطنيّة” الأساس الذي ارتكز عليه الجهد القَطريّ والتركي والعربيّ لتوحيد المعارضة السوريّة ضمن الائتلاف الجديد. وجرى تغيير شكل هذه المبادرة تمامًا خلال المفاوضات والاتصالات التي جرت في قطر قبل عقد الاجتماعات الرسمية، فتحوّلت إلى جسمٍ أوسع يفترض أن يشكّل نوعًا من البرلمان الذي يتولى تأليف حكومةٍ مؤقتةٍ وهيئةٍ قضائيّةٍ ومجلسٍ عسكريٍّ موحد، وهذا ما لم تتضمنه المبادرة الأصلية. وعُقدت اجتماعات تشكيل الائتلاف على أساس المبادرة المعدّلة.
تزامنت المطالبات الشعبية من الداخل السوريّ بضرورة وحدة المعارضة مع نشاطٍ دوليٍّ وإقليميٍّ وعربيٍّ ضاغطٍ، استهدف أيضًا تحقيق وحدة المعارضة السوريّة. وثمّة العديد من الأسباب والعناصر التي دفعت الدول المؤثرة في الملف السوريّ لإيلاء هذه القضية أهمية كبيرة، من أبرزها:
1. ازدياد رقعة المناطق المحررة نتيجة تنامي قدرة الجيش الحر، والتآكل الحاصل في سيطرة قوات الجيش النظاميّ السوريّ على الأرض.
2. ضرورة تشكيل بديلٍ سياسيٍّ عن النظام في حال انهياره.
3. ضرورة تشكيل حكومةٍ تدير شؤون الثورة وتتحدث رسميًّا باسم الثورة وتدير شؤون البلاد بعد الثورة مباشرة، وقبل تشكيل الحكومة الانتقاليّة.
4. مخاوف غربيّة تقليدية، تتلخص في فوضى السلاح، وتنامي قوة التيارات الأصوليّة، والدينيّة المتشددة.
5. مراهنة المبادرين وبعض الدول العربيّة والإقليمية الحاضرة في الأزمة السوريّة على انخراط أميركيّ أكثر فاعلية، بعد فوز أوباما بولاية ثانية في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وهذا من شأنه أن يكسر حالة الجمود الدوليّة في معالجة هذه الأزمة. والواقع أنّ الولايات المتحدة هي القوة الغربية الأكثر تريثًا في دعم الثورة السوريّة والتخلي عن النظام.
تعدّ مجمل المعطيات السابقة عوامل رئيسة فرضت على المعارضة السوريّة تجاوز خلافاتها والوحدة تحت مظلة الائتلاف الجديد. وعلى الرغم من أهمية هذه العوامل، والتي ساهمت في ميلاد الائتلاف، إلا أنّ تأسيسه لم يكن أمرًا يسيرًا. وقد جاء بعد مباحثاتٍ ومفاوضاتٍ طويلة بين أطراف المعارضة، وعلى رأسها المجلس الوطنيّ السوريّ الذي ارتاب بدايةً من المبادرة المطروحة كونها تتجاوز دوره و”مكتسباته” بشأن شرعية تمثيل الشعب السوريّ، وتفسح الطريق لترجمةٍ عمليةٍ لتصريحات أميركيّة طالبت بتفكيك المجلس وتجاوز هيكليته إلى جسم جديد. لقد نجحت المفاوضات في الوصول إلى توافقٍ على صيغة الائتلاف، إلا أنّ هذا الائتلاف لم يكن عمليةً اندماجيّةً للقوى السياسيّة المعارضة، بل كان – كما يعبّر عنه اسمه – “تحالفًا” بين المجلس الوطنيّ السوريّ بمكوناته المختلفة – والذي حصل على الحصة الأكبر من مقاعد الائتلاف (40%) – وباقي قوى المعارضة الأخرى التي لم تكن منخرطةً في المجلس الوطنيّ. أي أنّ الائتلاف مثّل صيغة توافقٍ بين المجلس والقوى التي كانت خارجه، وبعضها كان أصلًا في المجلس وانسحب منه. وإذا لم يتحول الائتلاف بسرعة إلى ما يشبه البرلمان الذي يصوت بالأغلبية، فسوف يصبح نسخةً مكررة من المجلس بنواقص المحاصصة ذاتها.
مقومات الفاعلية والنجاح:
لاشك في أنّ الإعلان عن ولادة الائتلاف يؤسّس لمرحلةٍ جديدةٍ في حراك المعارضة السياسيّة – والثورة السوريّة أيضًا – وهي مرحلة تختلف عن سابقتها من ناحية وجود قيادةٍ سياسيّةٍ موحدة تطمح لتشكيل بديلٍ سياسيٍّ وديمقراطيٍّ يتولى إدارة الثورة والمرحلة الانتقاليّة، وتحظى بدعمٍ مشروطٍ من الشارع المؤيد للثورة داخل سوريّة وهيئاته التنظيمية، وتلقى ترحيب غالبية الفصائل العسكريّة. كما تحظى هذه القيادة باعترافٍ دوليٍّ من الجامعة العربيّة والاتحاد الأوروبيّ والولايات المتحدة كـ”ممثلٍ شرعيٍّ لتطلعات الشعب السوريّ”، واعتراف كلٍّ من دول مجلس التعاون الخليجيّ، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيّا، وبريطانيا بها كـ”ممثلٍ شرعيٍّ وحيدٍ للشعب السوريّ”.
إلا أنّ هذا الترحيب في الداخل السوريّ، إضافة إلى الاعتراف الدوليّ، لا يمثّلان مقوماتٍ كافية لإنجاح الائتلاف الجديد، فالاعتراف الدولي في حد ذاته لا يمثّل نقلةً نوعية، إذ كان لقوى دوليّة وإقليميّة دورٌ أساسيٌّ في ميلاد هذا الائتلاف أصلًا، وعليه فإنّ الاعتراف الدوليّ يبقى في إطاره الرمزيّ ما لم يُترجم إلى: أولًا، الاعتراف بطابعه الوطنيّ السياديّ الذي يمنع التدخل في شؤونه؛ وثانيًا، تقديم دعمٍ عمليّ وفعليّ يجعل هذا الائتلاف قادرًا على أن يكون لاعبًا مؤثرًا في مسار الثورة السوريّة داخليًّا، وعنصرًا أساسيًّا في أيّ مبادراتٍ دوليّة وإقليميّة لفرض حلٍ سياسيٍّ على النظام السوريّ.
لقد كانت العلاقات الدوليّة للقوى السوريّة المعارضة حتى الآن عامل ضعفٍ لا عامل قوة. فقد منعت هذه التعددية في الاتصالات مع الخارج بناء سقفٍ وطنيّ يضم الجميع، كما منحت ملاذًا لكل من لم يرض بحصة، أو وفرت دعمًا يتيح له العمل على تشكيل جسم ما، أو أتاحت له ظهورًا إعلاميًّا، أو غيره. والأهم من هذا كله أنّها منعت تركيز دعم الثورة، وأدت في حالاتٍ إلى اتخاذ قوى المعارضة المختلفة مواقف متعارضة مع مواقف القوى الأخرى لإرضاء هذه الجهة أو تلك.
لقد كان هنالك تدخّل أميركيّ وأوروبيّ محدود في عملية التوصل لإنشاء الائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة السوريّة. وهذا من عناصر ضعفه. ولكن الوساطة الرئيسة في تشكيله كانت عربيّة، والسلوك الوطنيّ السياديّ الناجم عن وجود أغلبيةٍ وطنيّةٍ واضحةٍ من الشخصيات الموثوق بها سيمكّن من تجاوز هذا العطب، ويمنح هذه الأغلبية إمكانية أن تتصرف على نحوٍ مسؤولٍ في التعامل مع قضايا نظام الحكم الديمقراطيّ في سورية، وكذلك مع قضايا سورية الوطنيّة والقوميّة.
وليس هذا ممكنًا من دون فصل الخطاب الديمقراطيّ في معارضة النظام عن الخطاب الطائفيّ في معارضة النظام ذاته، وفصل العنف الثوريّ عن العنف الجنائيّ، والتمسك بعروبة سورية بالتوزاي مع منح الحقوق المتساوية لغير العرب، لأنّ البديل لعروبة سورية هو انقسام العرب إلى طوائف، ولأن عروبة سوريّة ذات علاقة مباشرة بوضعها الإقليميّ الإستراتيجيّ.
ويجب أن يكون واضحا في سلوك المعارضة أنّ حقوق السوريّين والموقف المعادي لأيّ طائفيّة أو شوفينيّة قوميّة هو موقفٌ سوريّ وطنيّ، ومصلحة سوريّة، وليس استجابةً لضغوطٍ أجنبية. فمن المهين وغير الديمقراطيّ أن تستمع أيّ قيادة سوريّة وطنيّة إلى نصائح – بل شروط – وزير الخارجية البريطانيّ بهذا الشأن، وكأنّ الموضوع هو حقوق الأقليّات في الدولة العثمانيّة في القرن التاسع عشر.
أما على صعيد الداخل السوريّ، فإنّ نجاح أيّ هيئةٍ معارضةٍ للنظام السوريّ تُشكَّل خارج سورية مرتبطٌ بأثره في إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في مسار الثورة السوريّة. وعلى الرغم من أنّ مسار الثورة محكومٌ بموازين القوة العسكريّة في الداخل، إلا أنّ الواقع يشير إلى أنّ الائتلاف يمكن أن يضطلع ببعض المهمات التي تمكّنه من الحصول على قيمة تمثيليّة وشرعيّة لدى المواطنين السوريّين، إذ إنّ الواقع الموضوعيّ يشير إلى أنّ الفاعل الأساسيّ اليوم في الثورة السوريّة هو الجانب المسلح فيها، من كتائبَ عسكريّة وفصائل الجيش الحر، وهي لا تزال تعاني من غياب التنسيق والتواصل فيما بينها، على الرغم من تحقيقها لانتصاراتٍ محليّة وسيطرتها على أجزاء واسعة من التراب السوريّ. كما أنّها تعجز حتى الآن عن بناء إستراتيجيات عسكريّة موحدة، وتغيب عنها الرؤية الإستراتيجية الواحدة أصلًا. ويكرّس ذلك اعتمادها على مصادر التمويل والدعم الخارجيّة التي تعكس توجهات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد السوريّ ومصالحها. ولن يكون بالإمكان الاستغناء عن الدعم الخارجيّ، ولكن لا بد من تنظيمه في إطار علاقةٍ سياديّة بين قيادة وطنيّةٍ سوريّةٍ موحدة ودول أخرى.
ليس متوقعًا من الائتلاف الوطنيّ أن يكون قادرًا على تمثيل الثورة السوريّة ما لم يصبح المسؤول الرئيس -إن لم يكن الأوحد- عن تمويل هذه الكتائب والفصائل المسلحة وإمدادها. أي أنّ ترحيب غالبية القوى المسلحة المبدئي يجب أن يتحوّل إلى علاقةٍ اعتماديّة من جانب هذه القوى على الائتلاف الوطنيّ. بالطبع، لا يرتبط الأمر بالأمنيات والقدرات لدى الائتلاف الوطني وقيادته وهياكله فحسب، بل أيضًا بإرادةٍ سياسيّةٍ للّاعبين الإقليميّين والدوليّين الذين أصبح لهم موطئ قدم في الداخل السوريّ، أن يحوّلوا دعمهم لهذه الكتائب والفصائل المسلحة ليكون من خلال الائتلاف الوطنيّ. فإذا ما كانت إرادة الدول الإقليميّة وبعض القوى الدوليّة واحدةً من العوامل الرئيسة لميلاد هذا الائتلاف، فلا بد من أن يترجم هذا عمليًّا في أن يتحوّل الدعم اللوجستيّ والماليّ ليكون من خلال الائتلاف، وإلّا فإنّ الداعمين لوجوده قد حكموا عليه بالفشل، ومسّوا بسيادة سورية المستقبل.
كما لن يكون وضع إستراتيجيةٍ عسكريّة موحّدة ممكنا طالما لم يقتنع كبار العسكريّين الذين انشقوا عن الجيش السوريّ أنّ عليهم الالتحاق بالكتائب المسلحة والعمل على التنسيق بينها، وأنّه لا قيمة فعليّة لوجودهم خارج سورية. ولا بد أن يساهم الائتلاف في عملية إقناعهم وتنظيمهم كقيادة ميدانيّة تنسّق فيما بين كتائب الثورة.
إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به على صعيد القوى المسلحة، فإنّ الداخل السوريّ يتوقع من هذا الائتلاف أن يكون له دورٌ أساسيّ على الصعيد الإغاثيّ، فقد فرضت المواجهات العسكريّة اليوميّة على مدار أكثر من عامٍ أعباءً كبيرةً على المواطن السوريّ في متطلبات حياته اليوميّة، وأوجدت أزمةً إنسانيّةً شاملةً ومتعددة الأوجه، تتفاقم باستدامة المواجهات العسكريّة وتوسّع رقعتها وحدّتها.
ويجب أن يحتل وضع إستراتيجيّةٍ إغاثيّةٍ شاملةٍ تلبي احتياجات المتضررين في سوريّة وتنفيذها أولوية جدول أعمال الائتلاف. وهنالك حاجةٌ إلى مجموعةٍ من الإجراءات العملية، بدءًا بتأسيس جهازٍ إغاثيٍّ ممتدٍ في المناطق المختلفة في سورية، ووصولًا إلى تشكيل جسمٍ ينسّق أعمال الإغاثة بين جميع الهيئات الموجودة أصلًا على الأرض، ويستطيع أن يزوّدها بما تحتاج إليه، أي أن يصبح الائتلاف المظلة الأساسيّة لتنسيق الجهد الإغاثيّ.
يعدّ تشكيل الائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة السوريّة نقطة تحوّلٍ إيجابيةً في مسار الثورة، كونها تحدّ من حالة التشتت والانقسام في صفوف المعارضة السوريّة. ويمكن أن تكون بدايةً لبلورة بديلٍ شرعيٍّ عن النظام الحاكم، يؤسس لخطابٍ سياسيٍّ عقلانيٍّ، وخطة واقعية للانتقال الديمقراطي، تضمن وحدة الشعب السوريّ، وتحقق طموحاته وتطلعاته. وقد وجد الائتلاف استجابةً معنويّةً مرحبةً في الشارع السوريّ الثائر.
يبقى أنّ صيغة نشأة هذا الائتلاف تتضمن عناصرَ قد تؤدّي إلى تكرار تجارب الماضي في إضافة هيئةٍ جديدةٍ من دون محتوى أو أثر. فعلى الائتلاف تجاوز عقلية المحاصصة وآلياتها ومنطق التوازنات بين الكتل المكوِّنة له وتسبيق ارتباطاتها الإقليميّة والدوليّة على حساب البرنامج الوطني للثورة السوريّة. أي أنّ الائتلاف الوطنيّ الذي نشأ كمحصّلة للتوافقات، يجب أن يتحوّل إلى إطارٍ مؤسسيٍّ يتجاوز الرُّؤى الضيقة والمصالح السياسيّة لعناصره. إنّ الضمان الوحيد لنجاح الائتلاف هو نجاحه على مستوى الداخل، وفي تحديد إستراتيجية إسقاط النظام، وسبل إدارة المجتمع السوريّ والاهتمام بشؤونه في ظلّ الثورة، ووضع خطةٍ انتقالية لما بعد الثورة. ويتطلب هذا إنشاءَ جهازٍ متفرغٍ مؤلفٍ من خيرة الكفاءات الوطنيّة السوريّة في الداخل والخارج، فمن دون جهاز تنفيذيٍّ وطنيٍّ تابعٍ لقيادةٍ سياسيّةٍ يقوم بالعمل الإعلاميّ والسياسيّ والإغاثيّ، ويشكّل حلقة وصلٍ مع الميدان، سوف يقتصر دور القيادة على عقد الاجتماعات التي لا تُنفَّذ قراراتها.
——————————
دراسة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات