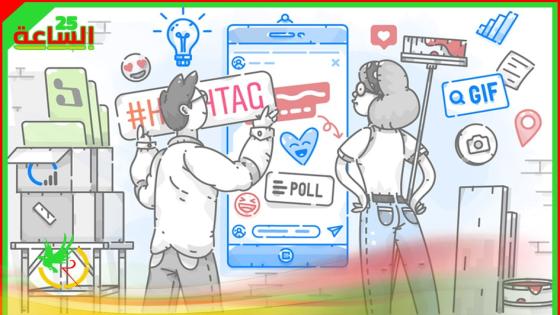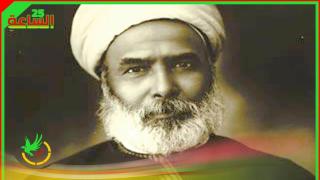«لم يقلقني الفعل يوما.. بل دائما يقلقني اللافعل»(ونستون تشرشل)
يوم 26 يوليو (تموز) الماضي وقف بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، في المركز التذكاري لضحايا مجزرة سريبرينيتسا في البوسنة والهرسك، التي ارتكبها العسكريون الصرب بحق اللاجئين المدنيين إلى «الجيب» المسلم المحاصر عام 1995، وألقى كلمة عصماء في الجموع جاءت فيها المقتطفات التالية:
«سريبرينيتسا كانت جريمة عصرنا»..
«سريبرينيتسا أرض مقدسة لعائلات الضحايا وأيضا لعائلات الأمة.. علينا أن نتعلم من دروس سريبرينيتسا. إن الأمم المتحدة تعمل، وستظل تبذل كل ما بوسعها لمنع حدوث سريبرينيتسا أخرى، في أي زمان وأي مكان لأي كان..»..
«علينا بذل أقصى الجهد لمنع ووقف إراقة الدماء، وتحديدا في سوريا الآن. عندما نتعلم من دروس سريبرينيتسا يتوجب علينا بذل أقصى الجهد. على المجتمع الدولي أن يتحد كي لا يرى مزيدا من إراقة الدماء في سوريا، لأنني لا أود أن أرى أيا من أولئك الذين سيخلفونني، بعد 20 سنة، وهو يزور سوريا ليعتذر عما كان بالإمكان فعله لكنه لم يُفعل في سبيل حماية المدنيين في سوريا.. وهو ما لا نفعله اليوم..»!
كلام جميل ومؤثر، ولكن بعد الاستماع إلى تصريحات لاحقة من المستر بان نفسه، عن «حتمية التسوية السلمية» و«التوافق»، يظهر أن الأجواء العاطفية المؤثرة في سريبرينيتسا طغت على مشاعره، لكنه نسيها بعد عودته إلى أروقة الأمم المتحدة، وغرقه في خضم المناورات والابتزاز والتواطؤ.
لا توجد لدي أرقام دقيقة عن عدد الضحايا والجرحى والمشردين في سوريا منذ 26 يوليو الماضي، لكنني أرجح أنه يدخل في عداد الألوف، لا سيما بعدما أتقن جلاوزة النظام الأمني الحاكم في سوريا تطبيق أسلوب فلاديمير بوتين الشيشاني على التراب السوري. وأيضا، بعدما ارتأى الرئيس الأميركي باراك أوباما أن خير وسيلة لدخول التاريخ هي الوقوف مكتوف الأيدي أمام المجازر البشعة بحق المدنيين، وبيعهم كلاما فارغا على شاكلة كلام بان كي مون.
كل ما طلبه الشعب السوري منذ فجر ثورته من أجل الكرامة والتحرر من هيمنة «مافيا» عائلية مذهبية فاسدة ودموية.. الحماية.. الحماية فقط.
عندما كتب أطفال درعا على جدران بيوتهم ما كانوا ينفذون أوامر صادرة إليهم من رجب طيب أردوغان.
وعندما تكرم عليهم وعلى ذويهم العميد عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس بشار الأسد، بنصيحته الأخلاقية القيمة حول المحافظة على النسل الصالح، فثاروا لكرامتهم وأعراضهم، فإنهم لم يفعلوا لأن دول الخليج علّمتهم الغضب على الإهانة.
وعندما ساروا في المظاهرات الحاشدة تحت هتافات «سلمية.. سلمية..» فإنهم حافظوا على سلمية التظاهر لأشهر طويلة على الرغم من زخ رصاص جيش النظام، وفي وجه سكاكين «شبيحته» وسموم إعلامه المضلل الذي دأب على التكلم عن «المندسين»، مع أن هؤلاء لم يعكروا ولو مرة واحدة مظاهرة استعراضية واحدة سيّرها النظام بالترهيب والترغيب.
النظام هو الذي دفع الشعب دفعا إلى الدفاع عن النفس والعرض. وهو الذي تعمّد تحويل الحركة المطلبية إلى مجابهة فئوية لإخضاع المجتمع عبر تفتيته وتدمير مقومات وحدته الوطنية.
النظام، مدعوما بالقوى الدولية القريبة والبعيدة –المعلنة والمستترة– المتفاهمة كلها على دوره التواطئي الإقليمي منذ أكثر من 40 سنة، هو وهي يتحملون المسؤولية الأخلاقية والسياسية في تدمير سوريا الوطن والتعايش إذا -لا قدر الله– انفصمت عرى التعايش بين مكونات هذا الوطن.
هل يمكن أن ننسى الإدراج الموسمي في واشنطن لسوريا على قائمة وزارة الخارجية الأميركية لـ«الدول الداعمة للإرهاب»؟ وهل يجوز ولو للحظة نسيان أو تناسي «حقد» إسرائيل المزمن والمزعوم على دور سوريا «الممانع»، الذي ترجمته في مهاجمة موقع الكبر في دير الزور ومعسكر عين الصاحب وغيرهما من الأهداف العسكرية؟ وهل يغفل أي مراقب، لديه الحد الأدنى من المعرفة، عن إدراك طبيعة العلاقة العضوية التي تربط نظام آل الأسد بالنظام الإيراني الحالي، والوجود الاستراتيجي الإيراني – ممثلا بحزب الله – على حدود إسرائيل؟
هذه مجرد أسئلة لا بد من طرحها لمحاولة استخلاص سبب التواطؤ الدولي الفظيع على مصير شعب كل جريمته أنه يطالب بالعيش الكريم، ومصير بلد عرفت أرضه بعض أعظم صفحات الحضارة العالمية، ووجد فيه أول نموذجين للتجمع البشري المديني في التاريخ.. هما دمشق وحلب.
قبل أيام، في المناظرة الرئاسية الأميركية بين الرئيس أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني، والتي كان التركيز فيها على الموضوع الاقتصادي، تألق رومني وخرج الإعلام الأميركي معلنا إياه فائزا في تلك المناظرة. وبالتالي، بدأت تحضيرات المعسكرين الديمقراطي والجمهوري للمناظرة الثانية التي ستتطرق إلى السياسة الخارجية.
هنا أتساءل عما سيقوله أوباما. هل في جعبته إنجاز واحد يتباهى به أمام الأميركيين باستثناء قتله أسامة بن لادن؟ وفي المقابل، أزعم – وقد أكون على خطأ – أن الجمهوريين، تحت قيادة اليمين «الحربجي» المتطرف سيركزون على «ضعف أميركا» وتراجع نفوذها، وتصاعد التحدي الروسي – الصيني لها.. ولن يكون عليهم النظر إلى أبعد من «الفيتوهات» الثلاثة للمحور الروسي – الصيني في الموضوع السوري، وتردد واشنطن في التعامل مع ملف إيران النووي.
جون بولتون، أحد «صقور» المحافظين الجدد – القدامى، هو أحد منظري السياسة الخارجية في المعسكر الجمهوري، وسبق لبولتون أن عمل مندوبا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مما يعني أنه خبير في لي الأذرع وتصيد الأخطاء لإدارة لا يشك كثيرون في سلامة نيتها تجاه المشاكل الدولية.. لكن كثيرين أيضا يشعرون بأنها في ليبراليتها المفرطة.. قليلة الواقعية وضعيفة الإرادة.
أخلاقيا ومنطقيا، أي سياسة خارجية أميركية بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تظل أفضل مائة مرة من سياسات أمثال جون بولتون و«المحافظين الجدد» وجماعة «حفلة الشاي» – الذين يلقبهم البعض في أميركا اليوم بـ«طالبان أميركا». غير أن تردد إدارة أوباما وضعفها المكشوف في وجه من يتحدونها، من بنيامين نتنياهو وزمرته الفاشية في إسرائيل، إلى «ملالي» طهران وأتباعهم وأتباع أتباعهم في سوريا ولبنان ومناطق عدة من العالم العربي، يدفع كثيرين إلى التفكير والمفاضلة، حيث لا يكون هناك مجال للتفكير والمفاضلة.
في السياسة المعاصرة، على الأقل، ما عادت النيات الطيبة كافية.. لأن الناس يريدون مواقف. ووقع المحاضرات الاقتصادية «الأكاديمية» كتلك التي أتحف بها أوباما جمهوره في مناظرته الأولى، هو تماما مثل وقع تصريحاته وتصريحات أركان إدارته في الشأن السوري.
هناك في أميركا شارع متحرّق لتحفيز الاقتصاد، ويريد حلولا سريعة من دون أن يكترث بمعرفة الجهة المسؤولة عن أزمته الاقتصادية، وهنا في سوريا مواطن معذب خائف على مصيره ومصير أطفاله من قصف الطيران الحربي ومجازر «الشبيحة».. ولا يهمه من يدخل البيت الأبيض ومن يخرج منه.
على المستر أوباما فقط أن يدرك أن التاريخ لا ينتظر المترددين.